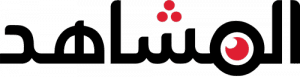تعز – منال شرف:
تربت الفتاة الريفية ريام الفقيه، على استقبال العيد بالممكن والبسيط، فلم تكن الملابس الجديدة مهمة بالنسبة لها، بل كانت تسعد بالزنة التي ترتديها لعيدين أو ثلاثة أعياد، وبحذائها المصنوع من المطاط، وبنقشة الحناء على ذراعيها، والتي تدفعها لانتظار فجر العيد بلهفة وشوق، دون أن يغمض لها جفن؛ لتسرع إلى إزالة الحناء، كالأخريات، ورؤية أثره، وقد تبكي إحداهن لأن لون الحناء لم يظهر جيداً، أو لأنه تشوه، بعد أن نامت عليه دون قصد.
وكانت والدة ريام تهتم بغسلها وأخواتها جيداً بالماء، وتلبسهن ما لديهن، ثم تقوم بتمشيط شعورهن بقوة، وهي تقول لهن: “ما يسبرش تبكين يوم العيد؛ خيبة”.
وقد تركت تلك الكلمات وقعاً خاصاً لدى ريام؛ فهي لاتزال تؤمن أن الناس من تصنع الفرحة الحقيقية للعيد، وبأبسط الإمكانيات.
وتقول: “كعكنا كان بسيطاً، وصبوحنا فتة مع السمن أو عصيد دخن مع السمن. أول العيد، كنا نتنقل من بيت إلى بيت لجمع المعايدة، ونروح ثاني العيد إلى قرية أمي؛ لنجتمع بأفراد العائلة، وتلتقط لنا الصور والذكريات، وعندما يحين وقت الغداء، تفرش سفرتان؛ واحدة للصغار، وأخرى للكبار، على أن نقوم بتنظيف الصحون بعدها، ثم تغيير ملابسنا، بينما يجتمع الرجال في مجلس، والنساء في مجلس آخر، أما نحن فنظل نتنقل ونلعب بين المجلسين”.
وتكمل: “ثلاثة أيام بين اللحم والحلويات واللعب دون راحة، كانت أياماً جميلة ننتظرها بشغف! بعكس الأعياد الأخيرة، فقد باتت مثلها مثل أي يوم عادي، وانصرف الناس إلى همومهم ومشاكلهم ووضع البلاد، ونسوا كيف يفرحون”.
لمة العيد
الكل يحمل معنى مختلفاً عن حقيقة العيد؛ فالبعض يعرفه بالملابس الجديدة والحلويات، والبعض الآخر يجده في الزيارات والضيوف، لكنهم جميعاً يتفقون على كونه لا يتحقق إلا باللمة والفرحة، وإن اختلفت أشكالها وأغراضها؛ ففي أيام العيد، يجتمع أفراد الأسرة الواحدة تحت سقف واحد؛ للحديث في شؤون الحياة، وأحوالهم، ومعايدة بعضهم البعض، وقد يأتون من أماكن بعيدة ومتفرقة.
ولا يقتصر الأمر على العائلة فحسب، فقد ينضم لأفرادها الجيران والأصدقاء، وكلهم يستغلون هذه الأيام للتقارب وتوطيد العلاقات أكثر.
تقول زهور ناصر: “قريباتي وجاراتي كن يأتين ليلة العيد إلى بيتنا؛ لنلتم نحن الفتيات في حوش المنزل، ونساعد بعضاً في إعداد الكثير من كعك العيد، كعك بالتمر، وأخرى بدون تمر، ونظل نعمل لساعات متواصلة، مستغلات الوقت في الحديث والدردشة والضحك، وما أجملها من لحظات برفقة بعض! أما يوم العيد، فكنت أقوم مع شقيقاتي بإعداد الخمير والكبدة والبسباس والشاي بالحليب، كصبوح لأفراد البيت، ثم نجهز الكعك والحلويات والزبيب فوق الطاولة للضيوف القادمين، بعد تنظيف البيت وترتيبه جيداً، وقد نغير ديكوره نوعاً ما، لكن الأهم هو البخور، وبعد الظهيرة، نعود للمطبخ لتجهيز الزربيان ولحمة المرق والسلطة والسحاوق وبنت الصحن، ونستمر على هذا الحال طيلة أيام العيد، الأمر الذي عزز من تماسكنا كأخوات”.
ويجتمع الأولاد ليلة العيد معاً، لأجل اللهو واللعب، كما كان يفعل حسام صادق في طفولته، حيث يلتقي بأطفال حارته ليلاً؛ للاحتفال بقدوم العيد، وإشعال المفرقعات النارية، وهم يرددون: “يا عيد يا عيد، والكل سعيد”، وفي أول يوم للعيد، يطوفون على بيوت الجيران، ويتنافسون على جمع “العُيادة” منهم، ثم يذهبون إلى الحديقة؛ ليستمتعوا بالألعاب والمفرقعات النارية ومسدسات الخرز وغيرها.
ويؤكد صادق أن العيد لمة، وفي ظل وضع كهذا، “كيف يمكن أن يحظى الناس بلمة دافئة؟!”.
ذكريات عيدية
لقد صارت فرحة العيد مجرد ذكرى للكثيرين، يستحضرونها كلما أوشك عيد جديد على القدوم، كما هو الحال مع هيثم المقبلي، الذي لايزال يتذكر قصص طفولته الطريفة مع العيد، حين كان مخزونه المالي يذهب كله لشراء السيارة الحديدية أو ذات الريموت، ويومها كان يحلم كثيراً بشراء “معسل”؛ ظناً منه أنه شيء يؤكل، وقد سعى مراراً لجمع المبلغ المطلوب، والذي يقدر بـ190 ريالاً يمنياً، وعندما تمكن من ذلك، أسرع بلهفة إلى صاحب البقالة، وطلب منه “معسل”، يقول: “سألني مستغرباً: لمن؟! قلت: لي، فقال: أيش بتسوي به؟! قلت: شأكله، طبعاً صاحب البقالة ضحك، وضحك أكثر عندما سألته: ما عدفيش نكهات؟! وبعدما أوضح لي استخدامات المعسل، عدت للبيت وأنا حزين للغاية”.
وتحاول رندا أحمد، جاهدة، التمسك بذكرياتها من خلال ممارستها في كل عيد، للحفاظ على مراسيم استقباله التي اعتادتها في طفولتها، بدءاً بتجهيز ملابسها للعيد، ورسم النقشة على ذراعها، وإعداد جدول خاص بخططها ومشاويرها، والذهاب للنوم مبكراً؛ لتصحو على تكبيرات العيد، وتذهب لأداء صلاته في المسجد مع جديها، ثم تنتقل لزيارة الأهل، والتلذذ بالحلويات، وارتكاب المقالب، وما إن يأتي أذان الظهر حتى تعود للبيت، فتجد كل شيء يفوح برائحة اللحم، تتناول غداءها، وتبقى تتحدث وتمزح مع أفراد العائلة، ولا يأتي المغرب إلا وقد أنهكها التعب، كما كان يحدث معها في صغرها.
ويقول إبراهيم الحكيمي: “صحيح أن أيام العيد كانت تشبه الأيام الأخرى بالنسبة لي؛ فقد كنت أرعى الغنم طيلة السنة، والغنم لا يعرف الأعياد طبعاً، ويحتاج للأكل. عودة الأهل هو ما كان يميز العيد؛ حيث يأتي بهم من المدينة محملين بالهدايا والملابس، وكل شيء غريب عن قريتنا؛ نظراً لانعدام البقالات في تلك الأيام، إضافة لتناولنا الكبدة مع الصبوح، بعد أن نكون قد ذبحنا أحد كباشنا كأضحية. وهذه معظم ذكرياتي مع العيد”.
“بأي حال عدت يا عيد!”
ويحمل بعض أبناء تعز نظرة سوداوية تجاه هذا العيد، خصوصاً مع انتشار جائحة كورونا، وتأزم الوضع في البلاد، حيث تخشى هناء جمال، وهي طالبة جامعية، من أن يستبدل الناس الملابس الزاهية بالأكفان، والمعايدة بالتعازي؛ نتيجة لما تشاهده وتسمعه يومياً من أخبار سلبية، ومن المرجح أن تدفع الاحترازات الوقائية بالناس لتجنب العادات المألوفة في العيد، كالتصافح، والتعانق، وااتقبيل، وقد تقيد حرية الطفل في اللعب، وتحرم العائلات من الخروج للتنفيس، بعد إغلاق المتنزهات والحدائق حفاظاً على سلامة المواطنين.
ويرى البعض أن لا شيء سيتغير، فما كان يفعله الناس في الأعياد السابقة، سيفعلونه في هذا العيد، دون اكتراث لما يحصل أو قد يحصل.
تقول ندى محمد: “مثلما مرّ رمضان، سيمر عيد الفطر، رغم التخوف الحاصل من وباء كورونا، لكننا شعب مستهتر وغير مبالٍ؛ ربما عدم وعي، وربما لكثرة الحروب والأوبئة التي عانت منها اليمن، وحولت أبناءها لشعب مستسلم وموكل أمره لله فقط، إذا ما فكرت توعيه، رفع يده للسماء”. مضيفة: “نحن شعب متمسك بالذي خلقنا”.
وتشير إلى أن الاختلاف الفعلي قائم بين الأعياد الأخيرة وأعياد ما قبل الحرب، حينما كانت تعجز عن النوم من شدة الفرحة، وتبقى تحتضن ملابسها الجديدة حتى يطلع فجر العيد، محترزة من أن يرى أحد حاجياتها، فيشتري مثلها، وكانت تتنافس مع الأخريات على من ستحصد أكثر مبلغ، ومن منهن تحمل أجمل نقشة حناء؛ لذا يسألن الأولاد بشقاوة: “أمانة من حقها أحسن؟!”.
وتختم بنبرة حزينة: “أتمنى أن تعود أيام زمان، كانت جميلة بكل تفاصيلها؛ القلوب صافية، والناس تحب بعضها، وتضحك وتبكي مع بعض، لكن الوضع تغير، وسواء في ظل كورونا أو عدمه، لقد فقد العيد بهجته مع سنوات الحرب”.