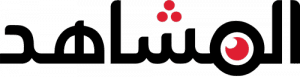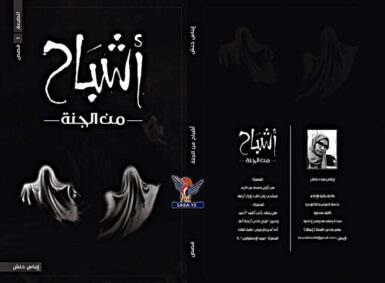تعز – محمد عبدالوكيل جازم :
إذا كان العالم عرف عبدالفتاح إسماعيل، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً؛ فإن الحقيقة تقول بأنه شاعر بالدرجة الأولى، ويتوجب علينا أن نفهم أنه شاعر صوفي، قابل الحياة بذهن منفتح على الطبيعة، وبصدر مغرم في الوقوف ضد الظلم والطغيان والأحقاد والأباطيل. شاعر لا يرى من هذا الوجود سوى صفاء القلب وألق الروح ونور المعرفة.
وسوف يتذكر التاريخ كثيراً أنه مرّ على رئاسة اليمن رئيس جمهورية قرض الشعر الحديث والمعاصر، وكتب قصيدة النثر كما كتب قصيدة التفعيلة والشعر العمودي. رئيس تمتع بذهن متقد وفهم عميق وخيال منقطع النظير. عانق الأدباء في كل مكان في الداخل والخارج، وعاش متلمساً خيال المفكرين والفلاسفة والنقاد.
وأزعم أنه قاد اليمن بروح الفنان، ونظر إليها بعقل المبتكر الشغوف؛ فكان مروره عليها خفيفاً كما يمر الشعراء وعابرو السبيل.
ويبدو أن مردّ ذلك يعود إلى أنه تأثر بطقوس الحياة الصوفية والشعر الصوفي الذي تشربه في بيئة متكاملة تربى فيها وتنقل بين أفيائها وجنباتها حدّ الثمالة، وذلك في وقت مبكر من حياته؛ فمن خبر تلك القرى عرف أنه لم تكن تمر الأيام والأسابيع إلا وهي تحتضن الموالد وجلسات الشعر والأناشيد الروحية والذكر الصوفي، ولعل الدارس سيلحظ اليوم أن قصائده، مشحونة بهذا الشجن، ونجدها متضمنة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأضرب مثلاً على ذلك، وهو قوله تعالى: “لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار”، وقول رسول الله: “المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين”.
ولعل الذين رافقوه حياً وميتاً، يعرفون جيداً سمو أخلاقه وعلو همته، والتصاقه بسلوك الصوفيين؛ التي يغلب عليها الزهد والتقشف والإثار، والإعراض عن سفاسف الأمور ومروجي الشائعات.
يقول إسماعيل في ديوان “نجمة تقود البحر”، الصادر عام 1989م، عن دار ابن خلدون، في قصيدة “حوارية للتأمل”:
“قالوا امتشقت من مولد الفجر أنغامه
يصدح قلبك فتسمع الآذان كلها
أغنية مقاماتها تخصب في التربة البكر
قمحاً ونخلاً
تحيل العبوس، والبؤس
في الضفتين بسمة لرياح النهار”
إذا تفحصنا هذا المقطع؛ وجدناه صوفياً بامتياز، وشاهدنا على ذلك المفردات الخاصة بقاموس الصوفية، ومثل ذلك “مولد الفجر” التي تعني التوحد بإشراقة يوم جديد، يصدح القلب “بالتسابيح”، “أغنية مقاماتها”، المقامات طقوس صوفية، وكذلك الأغاني في حضرة الطار.
قد يرد سائل هنا لماذا تساءل فتاح عن جنة عرضها السموات والأرض؟ أقول لأنه تحلى بطباع أولئك الذين يحبهم الله: المؤمنون عن دراية وعلم، وبالتالي تأثره بالفلاسفة والصوفيين الكبار الذين يصلون إلى السماء فينكرونها أحياناً، ويجحدون بها، ثم يعودون إلى أحضانها، ويرضون عنها، وهي علامة ودرجة لا يصل إليها إلا الباحثون عن لحظة الفناء.
وبداية، لا بد أن نلتفت إلى عنوان القصيدة الذي يشكل مفتاح القراءة؛ فالعنوان: “حوارية للتأمل”، والتأمل كما نعرف ظاهرة وطقس صوفي، وقد ساوى الشاعر مفردة حوارية بالتأمل؛ لأن اللحظة الصوفية في هذا المقام ليست جامدة، وإنما صاخبة.. حوارية.. فاعلة، وهذا يعيد إلى أذهاننا مقولة “كولن ولسون” بأن “الشعر والتأمل متشابهان في أساسهما، فلهما نفس الهدف”، وهو بذلك عنى الشعر الصوفي.
مدخل
ربما تحتاج هذه الورقة إلى اتفاق مبدئي قابل للنقاش، لذا أود أن أقول للقارئ: لنتفق أولاً على جملة من الشروط:
1- ليس كل من يعلن أنه متصوف، يعد صوفياً؛ فالمتصوف إنسان لا يعلن عن نفسه، ولا يكشف سره، لأن كشف الأسرار في التصوف يعني الموت، وفي ذلك يقول السهروردي:
“بالسر إن باحوا تباح دماؤهم
وكذا دماء البائحين تباحُ”
وقد عاب بعض المتصوفة على الحلاج كشفه للسر الذي وصل إليه جنونه.. جنونه الذي قاده إلى أن توضأ بدمه.
اللحظة الإشراقية، وهي اللحظة التي يذهب معها صاحبها إلى تجسيد تجربته الحياتية على شكل نص شعري كما هي عند شاعرنا عبدالفتاح إسماعيل، التي يمكنني أن أسمي لحظات كتابته للشعر لحظات بهاء وتجلٍّ عميق.. بهاء لما تكتنزه من قوة في الخيال ودقة في التصوير وتدفق في المشاعر، وتجلى ذلك في توحده بفكرة واحدة عنوانها.
2- التصوف: سلوك، فإذا كان المتصوف شاعراً، ظهرت الصوفية في خطواته وسكناته، دون أن يعلن، وبانت في أدائه الشعري والكتابي كما هي في نثريات النفري والبسطامي وأشعار ابن علوان وابن عربي وابن عجيل والحلاج.
3- التصوف لحظة متكررة داخل الروح؛ فالروح التي تخرج عن نفسها، تعود لتتحد بنفسها، في لحظة إشراق. وبين الخروج والعودة يحدث ذلك التطهير الذي نسميه أحياناً صفاء، وأحياناً محبة، وأحياناً إبداعاً، وأحياناً تصوفاً وأحياناً اللحظة الشعرية؛ أو ما يسميه الصوفيون اللحظة الإشراقية، وهي اللحظة التي يذهب معها صاحبها إلى تجسيد تجربته الحياتية على شكل نص شعري كما هي عند شاعرنا عبدالفتاح إسماعيل، التي يمكنني أن أسمي لحظات كتابته للشعر لحظات بهاء وتجلٍّ عميق.. بهاء لما تكتنزه من قوة في الخيال ودقة في التصوير وتدفق في المشاعر، وتجلى ذلك في توحده بفكرة واحدة عنوانها “محبة الأرض والإنسان”.
إذن، فاللّحظة التي يختلي فيها الإنسان مع نفسه -من أجل العبادة أو الكتابة- هي لحظة تصوف، إذ يتنقّى فيها الإنسان من شوائب الحياة وضجيجها وملابساتها. لا شك أن العبارة الأخيرة تمثل ذروة القول في ما نريد طرحه، وفي ما نذهب إليه من أن الإنسان يستطيع أن يخلق لحظات صوفية خاصة به؛ فالصوفي لم يعد ذلك الإنسان الذي ينقطع عن الناس للعبادة والصوم عن الأكل والكلام، وليس ذلك الذي يرتدي الثياب الممزقة المرقعة المتسخة، ولكن، على العكس من ذلك، الصوفية تعددت اليوم بمعانيها ومدركاتها وطرقاتها.. تعددت في مضامينها وأفكارها ووسائلها، وصار المهندس والطبيب والمؤرخ والرحالة والأديب جميعهم يخلقون لحظاتهم التوحيدية في معاملاتهم ومسارات حياتهم. الإنسان الذي يحب عمله إلى درجة العشق، يقال له صوفي، والشاعر أو الأديب الذي يخلص لتجربته، يصبح صوفياً.. الشاعر المعتاد على الذهاب إلى دوائره الإبداعية من حيث يدري ولا يدري، يعد مبدعاً وشاعراً صوفياً. وهذا الخط المتفاعل مع الناس أسسه القطب أحمد بن علوان، وسار على نهجة عبدالفتاح إسماعيل.. ألم يقل ابن علوان ذات يوم، مخاطباً السلطان:
“هذي تهامة لا دينار عندهمُ
ولحج أبين بل صنعاء بل عدنُ
عارٌ عليك عماراتٌ مشيدةٌ
وللرعية دورٌ كلها دُمنُ
فانظر إليهم فعين الله ناظرةٌ
هم الأمانة والسلطان مؤتمنُ”
لحظة الإبداع، إذن، هي لحظة الإشراق المعروفة لدى الصوفيين، تلك اللحظة التي تأخذ صاحبها إلى عالم آخر.. تأخذه من ملذات الحياة ومن صخبها وجمالها ورونقها، إلى عالم آخر: هو مزيج من الوعي واللاوعي؛ يقول شاعرنا في قصيدة “خواطر في مستشفى هافانا”:
“رغم عالمي الجميل الجديد، شردت، في الأفق، لكي
أرى.. ولا أرى
حيث الحدود بلا حدود
والوعي.. واللاوعي
لا يستطيع أحدهما أن يقود الآخر
والصراع يهدأ لكي يعود
فالوعي رغم الحضور تبدد وذاب
أحياناً تكمن الحقيقة في اللاوعي
واللاوعي حاضر رغم الغياب”
ما التصوف؟
ما هو التصوف؟ ومن هم الصوفيون..؟ وما هي صفات الصوفي؟ وماذا يريد المتصوفة؟ ما هي أوصافهم العامة، الظاهرة والباطنة..؟ أين يتواجدون؟ وكيف يمكن تمييزهم عن بقية الخلق..؟ هل هم كثيرون؛ أم أنهم قليلون.. يحتفي بهم العالم أم يزدريهم..؟
كل هذه الأسئلة يمكننا أن نقترب منها ونلامسها:
التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من “صوف” للدلالة على لبس الصوفي، ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية يسمى في الإسلام صوفياً(1).
وورد لفظ الصوفي لقباً مفرداً لأول مرة في التاريخ، في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي، إذ نُعت به جابر بن حيان، وهو صاحب كيمياء شيعي من أهل الكوفة، له من الزهد مذهب خاص(2).
أرجح الأقوال وأقربها إلى العقل: مذهب القائلين بأن الصوفي نسبة إلى الصوف، وأن المتصوف مأخوذ منه أيضاً، فيقال تصوف إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص إذا لبس القميص؛ فلهذا القول وجه سائغ في الاشتقاق، وهو مختار كبار العلماء من الصوفية، مثل صاحب اللمع وشارح الرسالة القشيرية، ومن غيرهم كابن خلدون وابن تيمية(3).
هناك ألفا تعريف للصوفية؛ حيث يستطيع كل صوفي أن ينتهج تعريفاً خاصاً به، هناك من يرى بأن الصوفية: سلوك أخذ من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من يرى بأن الصوفية: سلوك متصل بالعمل والقلب، وهو سلوك يوصل إلى الله. وهناك من يرى بأن التصوف علم يختص بترقيق القلوب والعقول.. وهناك من يرى بأن الصوفية توحد مع الله والكون.
والتصوف ظاهرة موجودة في جميع الأديان، والمؤمنون بها موجودون في كل مكان، تختلف طرائقهم في الحياة عن بقية الخلق، فهم أكثر قدرة على التأمل، وأكثر قدرة على الاستفادة من لحظات خلواتهم، ويتصفون بالصبر والمثابرة من أجل الوصول إلى الهدف، وهدفهم السامي هو الوصول إلى لحظة فناء.. لحظة يسميها البوذيون “النارفانا”، وتعني حالة السعادة القصوى؛ أو منتهى الرضا والقناعة. ولعلنا نستطيع القول إن هذا ما توصل إليه شاعرنا المدرك من أن اللغة العربية استطاعت أن تختزل الصوفية بمعناها العالمي المكثف، الذي يؤمن بـ”التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل.. ثم التجلي”.
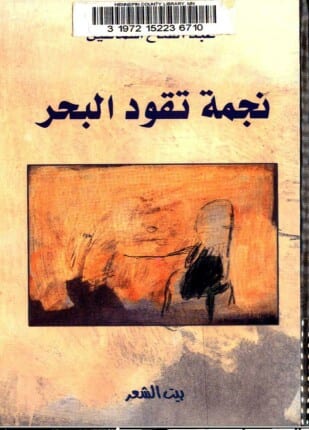
إن من أهم مقامات المتصوفة ثلاثة عناوين ذكرها معظم العارفين، وهي: الزهد، والتوكل، والمحبة.. وهي مقامات نستطيع استخلاصها من الديوان المفتوح بين أيدينا، بخاصة إذا عرفنا أن الفن لدى المتفانين: محاولة من الإنسان لامتلاك تثبيت التجربة كما يمكن إعادة خلقها(4).
الزهد
نعرف جميعاً أن الزهد ارتبط شعرياً بالشاعر الزاهد أبي العتاهية الذي ذهب إلى الإعلاء من قيم تهذيب النفس، ولا شك أن لكل إنسان عالمه الخاص به، المتوحد معه، عالمه الذي يشعر أن فيه خلاصه، وهو عالم يشعر فيه الإنسان -أحياناً- أنه متسق مع دواخله، منسجم مع مفرداته: الناس، الطبيعة، الكون، الحلم، الأمل، والشعر. إن اختيار القصيدة هو في الحقيقة زُهد، لأن الإنسان كلما كان قريباً من الشعر، وأخلص له، نسي ملذات كثيرة، وتوحد بعالم خالٍ من الزيف والذاتية. يقتنع الشاعر بالقليل من مقومات الحياة، وذلك لأنه مشغول بالتقاط اللحظات والصور والأنفاس الطائرة في فضاءات الروح.. بعيداً عن طلبات الجسد المثقل بأحماله والمشدود إلى القاع.
يستولي على الشاعر دائماً شعور بأن هناك من يشاركه خصوصيته، وهو إيحاء يضعه الله في مجاهل النفس، مثل خيط من النور وعرق من الدم المضيء، ونتيجة لذلك يحس الشاعر أن عليه مسؤوليات تجاه هذا العالم. ومن الشعراء الزهاد شاعرنا إسماعيل؛ الذي رأى أن حياته لن تتسق وتمتد وترسل إشعاعها إلا إذا أسهم في البحث عن جوانب الحياة فيها، تلك الجوانب التي تكنز في أعماقها أدوات النجاة للجموع، يقول:
“الأيدي يمكن أن تحجب النور
حقاً هناك من يزرعون الوباء
جرثومة.. درهماً.. غدراً أو فتنة
وما قد يدغدغ بعض الحواس
ومن حيث لا يدركون أو يدركون
يرتد سهم ذلك الوباء إلى نحرهم
فالحب حين يضاجع الأرض، والبسطاء
معتجناً الكلم بالفعل،
سيتحد الجرح ورغم المعاناة يشفى”
وهكذا نجده في كل مرة هائماً يبحث عن النور الذي يعمل الآخرون على حجبه. يقول الشاعر هنا وهو المجرب: “نعم هناك أيدٍ تحاول حجب النور، وربما استطاعت بعض الشيء، مستخدمة الإغراءات حيناً، والغدر حيناً، والإغراء بالدراهم، والغدر بالفتن، الترغيب والترهيب، بكل ما قد يضعف الإنسان ويخيفه، ولكن ما يحدث هو أن سهامهم تعود إلى نحورهم، لأن منطقه غير منطقهم. أما هو فقد زهد عن متع الحياة التي يرغبون بها أحياناً، واختار طريق المحبة”.
إن مفردتي “سيتحد الجرح” في نهاية المقطع السابق، لا تعنيان شيئاً قدر ما تعنيان أن الشاعر لا يبحث عن حل له وحده، وإنما له ولمن حوله، وبخاصة البسطاء، والأرض التي يتيه فيها حباً.
من الزهد التنكر للذات. فالقصائد لا تتحدث عن الذات المفرد الواحدة، وإنما معظم قصائد الديوان تُغيب الذات معليةً من شأن الجماعة:
“وهأنذا بصلابة قلب خنادقكم
في النصر وعند هزائمكم
وبسُمكِ ارتفاع أحداق أسواركم
وعند الشدائد، قشطت بسيفي الركام القديم
الجديد
فتحت نافذة المقبرة
لمخاض الربيع الآتي إليكم”
في مقطع آخر يقول:
“لذا قالوا إني داعي النبوة للكفر والبدعة والزندقة
لأني لفظت سموم الطوائف
مفخرة الابتزاز
حيث ترزق الآلهة من تشاء
بغير حساب
في سفرة الميمنة
وذوبت أحشاء روحي
مع البسطاء غذاء لشمع البشارة”
إن الإنسان الذي يختار الشعر طريقاً ودرباً له، يعد صادقاً؛ فالشعر هو أن تكون ضمير الناس، والشعر هو أن تقول الحقيقة. ولعلنا قد لمسنا شكوى الشاعر مما يقوله الخصوم عنه، فهذه عادة الخصوم، وإنما يقولون ذلك لأنه زهد عن التملق لملوك الطوائف، ولمن يفخرون بالابتزاز، ولكل أصحاب الثروات، واختار أحشاء الروح لكي يحس من هناك ومن موقعه الزاهد بآلام الفقراء، لأن الزهد عن كل الملذات غذاء وبشارة للمستقبل؛ لهذا تراهم يشبهونه بالحلاج الذي اتهمه قاتلوه بمدعي نبوءة الكفر والزندقة، حين قال أنا الحق، ويعني الرافض للظلم، كما هي روح شاعرنا المنبثة في كل جنبات الديون.
وفي مقطع آخر يقول:
“هذا الخيار
اختبار لنا وأي اختبار
شدّاد ما كان يوماً بأسطورة
ولا إرم ذات العماد”
إن الزهد هو في الحقيقة درجة من درجات الإيمان، ومن يصل إلى هذه الدرجة يذهب إلى اختبار قواه الإيمانية. يقول لنا الشاعر: لكي نصل إلى بطولة عنترة بن شدّاد المعروف في التاريخ العربي، ولكي نصل إلى “المدينة المثالية” إرم ذات العماد، علينا أن نختبر أنفسنا وشهواتنا، وعلينا أن نزهد عن بهارج هذه الحياة الفانية. إن الصوفي الحقيقي هو من يدرب نفسه على الاختبار لأنه بذلك يتجدد ويتطهر؛ لنتأمل هذا المقطع الذي يجسد فيه الشاعر صورة الزاهد المحب الذي برّحه الشوق بسبب معاناته وتقشفه، وحروبه المستمرة مع النفس والآخرين:
“أطلّ عليكم
بوجه ودود
براه عذاب صراع الزمان
طولاً وعرضاً”
التوكل
ليست الصوفية مرادفاً للكسل والخمول، وهي ليست الانقطاع عن الخلق في بيوت العبادة، لا.. الصوفية الفاعلة هي الطريق التي ارتآها شاعرنا.. وهي طريق كفاح، وعمل، وجهاد، واجتهاد… كدّ وسعي وسهر وعطش. إنها عمل شاق يجرّب من خلاله المحب كل أهوال الحياة، للوصول إلى اللحظة الأخيرة التي هي بالفعل لحظة تجربة صوفية، وهذه اللحظة تكثفت في خاتمة قصيدة “الثورة والموت والميلاد”:
“عالمنا اليوم، يركض فوق صهوة خيل
نحو الشرق
يمخر عباب البحر
يتحدى الإعصار
يمضي ليعانق شمس الحرية الكبرى
يزرع بديلاً للعبث واليأس، والأمل الأخضر
في كل مكان ليحقق ما كان أحلاماً
ينشر بسمته في المدن والأديان
بين البسطاء، بين العشاق”
إن خيط النور، الذي يتحرك في أعماق الشاعر يقول له: توكل، اذهب إلى الناس، تفاعل مع قضاياهم، مع أحلامهم واتجاهاتهم. ولا شك أن ذلك الخيط هو نفسه الذي كان يقول له من حيث يدري ولا يدري: أيها الزاهد أسهمْ في تحرير بلدك من الإنجليز، قاتل مع أهلك ومحبيك وأبناء جلدتك، قاتل بالكلمة والموقف والسلاح. وكانت هذه اللحظات الإشراقية الصادقة تتناثر على شكل فعل وأداء سلوكي ومقاطع شعرية تعكس طبيعة الإنسان في تلك المرحلة.
إن التوكل الذي أعنيه في هذه المادة، هو أن كل قول شعري كان في الحقيقة ناتجاً عن موقف عملي جسّده الشاعر في ذخيرته الإبداعية. ورأى، وهو المؤمن، المتوكل، المحب، أن كل شر يُوجب المواجهة. إن الكثير من المقاطع الشعرية أفصحت عن محارب لا يستطيع أن يفعل شيئاً سوى تحطيم المخاطر المحدقة بعالمه الصامت. نستشف ذلك من تلك القصيدة التي رثى بها رفيقه عبدالله باذيب:
“زبانية الليل يبتسمون، فهل نبكي؟!
جذلون، فهل نحزن
على من حمل الحرف الوضاء، الحرف السيف
وحمل القلب على كتفيه ينز النور؟!”
التصوف -كما يعرفه الدكتور علي الخطيب- في حقيقته إيثار وتضحية، هو نزوع فطري إلى الكمال الإنساني، والتسامي، والمعرفة. نجد في هذه الخلاصة شيئاً من الإيثار والتضحية والبحث عن الكمال:
“لكن ثقي يا حبيبتي مهما كانت أو تكن مخاوفي
ومهما ساورني القلق بعد اليقين
ثقي بأن حبنا واعد كما تعد الرعود
حبنا زاهر كما تعد براعم الثمر
وحبنا خالد كنور الشمس والقمر
ثقي يا حبيبتي بأن حالتي كيفما تكون
تظلين بالنسبة إليّ حبي الكبير
تظلين بالنسبة إليّ نور العين” (ص63)
المحبة
تناول الشعراء العرب الكبار التراث الصوفي في أعمالهم، وأسقطوا مواجيدهم وأقنعتهم وأفكارهم على شخصيات صوفية بعينها، ومنهم -على سبيل المثال- صلاح عبدالصبور في مسرحية “مأساة الحلاج”، وأدونيس في تماثلاته مع النفري، والدكتور عبدالعزيز المقالح في حواراته مع ابن عربي في “أبجدية الروح”، وعبدالوهاب البياتي في ابن الرومي، ومحمد عبدالولي في مسرحيته القصيرة “بشر الحافي”، وكثيرون غيرهم. شاعرنا كان كل ذلك بكمية الوعي الإضافي الذي يطرق باب قلبه.. قلوبهم جميعاً، حين أصبح هو الشخصية والتجربة، والقناع؛ فقد عاش اللحظة الصوفية بتفاصيلها، وعبر عنها بلواعجها وأشجانه.
ما أحوجنا اليوم -ونحن نعيش هذه الحرب المدمرة- إلى أن نُحيي في الناس جذوة الشعر الفاعل. وما أحوج نخبة المثقفين والسياسيين اليوم إلى أن نحثهم على اكتشاف جوانب المحبة والتصوف في أعماقهم.. كما فعل هو. وما أحوجنا اليوم إلى أن نحيي أشعار وأفكار هذا الرجل الشاعر المتصوف المثير للجدل. ما أحوجنا إلى أن نمد جسور معارفه إلى الحقل الأكاديمي الدراسي والفكري، خصوصاً وأنه قصد في ما كتبه نشر قيم المحبة والإخاء البشري والإنساني، قبل أن يصل آخرون.. وهي نظرة يختلط فيها التنبؤ مع قراءة الواقع، في هذا المقطع من قصيدة “كوبا” نجد أنفاس ابن عربي:
“تحلم بحب إنساني آخر
يكسبها دوماً عمراً أخضر
لا يميز أشكال الإنسان
لا يفرق بين الألوان
يتعانق فيها الأبيض والأسود والأسمر
وما كان أملاً في الغيب
حلماً أشقر
أصبح غيم ضياء”
يتجلى نفس ابن عربي بفلسفته الصوفية وقدرته على إثارة الجدل بدعوته الدائمة إلى حرية الخلق في العبادة والمعتقد.. وهو القائل:
“لقد صار قلبي قابلاً كل صورة
فمرعى لغزلان ودير لرهبانِ
وبيت لأوثان وكعبة طائف
وألواح توراة ومصحف قرآني
أدين بدين الحب أنّى توجهت
ركائبه فالحب ديني وإيماني”
ويتجلى ذلك في هذا المقطع الذي كتبه شاعرنا تحت عنوان “قصيدة”:
“منطق:
الكره والخير
والحب والشر
كل الأشياء تختلط، فليس من عجب
أن النقيض بالنقيض
مرتبط لكن من لا يعي جدلاً
سر الحياة ينتابه الشطط
الحقيقة تبرز واقفة على رأسها
والحال يبدو جلياً
كله غلط”
في مسارات المحبة ودروب الضوء يتمشى شاعرنا حاملاً بين جوانحه قناعات العصفور الممتشق سيف غنائه؛ العصفور الذي لا يستطيع هجر شجرته، يطير إليها ليودعها أسراره التي لا ترى:
“أتخفين سرك عني؟ وأسرار سرّك واسمك اسمي..
النار تشعلني من جمر قلبك والبرد
يقذف بي من حزن عينيك
برد ناري
ونار سلمي.
فكيف أقيس عذابي لأجلك
ووشم عذابي بجسمك
وجسمك جسمي” (ص63)
هناك عادة يمنية تحضرني الآن، ومفادها أننا لا نلتفت إلى إبداعات شعرائنا وكتابنا، منطلقين من مبدأ شائع “لا كرامة لنبي في وطنه”، وذلك لأننا نسينا أهم شروط الحياة، وهي المحبة، أما إذا التفت إليهم الآخرون، ونبّهوا إلى إبداعاتهم؛ فإننا نفكر بإنصافهم جزئياً، وربما لا نقتنع، فكيف نتنكر لأصالتنا. ومثل هذا حدث مع شاعرنا الذي تنبه إلى إبداعه الآخرون، وأقصيناه نحن رغم شعريته الواضحة وذوبانه الشديد وحبه لامرأة واحدة تسمى “اليمن”.
“يدور الزمان ويوماً تحرك نحوك
توقف عندك بكل الأماني إليك يشير
يجلجل يعلن ميلادك المحتمل
حضنت الأمل وكالجمر أزهر حبي الكبير” (ص29)
من أجل هذه المحبة الاستثنائية النقية الصادقة، أقول لنتوقف هنا، لكن القصيدة المتلفعة بالوجدان تشرئب من بين جوانحنا، لأننا ربما عطاشى جائعون لتذكر مثل هذا العلو، لأن المحبة هنا اكتملت، وهي محبة خالصة يختلط فيها نفس المحب مع نفس المحبوب، حتى لا يعرف المحب أين روحه من روح محبوبه، يقول:
“روحي معك
تغني وتبكي، تضمك دوماً
وحين تحلق فيك، نحو المعالي تطير
فترعاك ليلاً ونهاراً
قريباً وبعيداً
وفيك شقائي نعيماً يصير
وقلبي يشرق منك ويغرب فيك
كدقات قلبي ومن
عمق حبي
أخاف، أغار عليك
وكل الذي في يديك
جذوب طروب مثير” (ص30)
“المحبة هي أصل جميع المقامات”، حسب ابن الدباغ، يصل الإنسان الصوفي عبرها إلى مقامات أخرى، كمقام الحرية التي ينتفي فيها الشعور بالثنائية تماماً، وتصير فيها الأنفاس متحدة في شهيقها وزفيرها، ويتمظهر ما يسمى الإحلال، وهذا يتجسد في قصيدة “فكرت فيك” العامية:
“فكرت فيك كثيراً
احتار فكري
نظرت إليك
غريباً نظرت لذاتي
التفت فيك لمحت غرابة أمري
أدركت بأني
بدونك لا وجه لي
حدّقت فيك.. رسمتك
تغير شكلي
أصبح وجهك وجهي
مقام العشق” (ص63)
إنه المقام الذي افتدى فيه الشاعر عبدالفتاح إسماعيل حبيبته بدمه.. النهاية الأخيرة لمعراج الجسد، والبداية المهرجانية لبداية الحياة؛ يقول في قصيدة “آزال ولعبة الألوان”:
“هل يكفي ذلك يا تربة حبي؟
وها إني أحمل مطرقتي، فأسي
لأحطم إبريق السم وعلب لفافات الأفيون
لأحطم هذي “الأوثان” الألوان..
وأقدم نفسي للنار
فلأحترق الساعة كي ينبعث آزال العصر
من الجسد المحروق، كتلة جمر
تحرق لعب الألوان وتكون اللون لترابك
وأنا القربان” (ص70)
طقس صوفي مكتمل ينتهي صاحبه كقربان. وفي مقطع آخر يظهر الشاعر المتصوف وهو في لحظة عشق وجذب سماوي؛ يرى ما لا يراه الآخرون، مخترقاً الزمان والمكان، وفي تلك المراسيم التي يتوارى فيها جسد رفيقه “باذيب الثرى”، في تلك اللحظة البهية يرى قامته المديدة وهي تختفي بين النهدين، منطلقة إلى دورة جديدة في الحياة:
“يا قلعة المجد، الحب
ويا أغنية الخصب، يا بلادي:
ابنك وضع القلب بين النهدين
وسافر
يحمي في ساحات النور
بيد، عينيك، وبالأخرى رايات
حبك”
ويمثل العشق أعلى مراحل الجنون المطلق الذي يصل إليه المتصوف، وقد استخدم الشاعر مفردة العشق كثيراً في هذا الديوان؛ يقول:
“من يعشق التوحد بالبحر
يعشق شواطئه الخضر” (ص33)
حكمة وشيجة الصلة بالفناء.
ولكي أُجمل ما أود قوله، ولا أستطيع، هناك سمات وملامح عامة واضحة في الديوان، منها:
- أن الشاعر تمثل جدلية الحوار المتلمسة جنبات الباطن وأحراش الوجدان، والشبيهة بالعذابات اللذيذة في أشعار الصوفيين التي تناجي الذات الإلهية عادة، بخاصة تلك النبرة المتضمنة الشد والجذب بين حبيبين لا كلفة بينهما، وقد نجد دلالة لذلك في قصيدة “السؤال”.
- استخدم الشاعر الكثير من المفردات الخاصة بقاموس الصوفيين.
- الصوفيون ليسوا رجالاً عاديين يسهل قيادتهم والتأثير عليهم، فقد توصلوا إلى ما هم عليه بعد مرورهم بالعديد من الانصهارات الإيمانية، وهم لا يتعبدون الله من أجل الجنة أو من أجل الحصول على مكافأة، وإنما من أجل المعرفة، والمعرفة لديهم سعي إلى الخالق، ويتجلى ذلك في قصيدة “الشك”:
“معذرة كيف لي أن أطمئن وفي عمق صلب اليقين
مدى الشك
تنخر قلب اليقين
ويشتعل الشك ناراً تموج في النفس
تمتد نيرانها تستكين
وتوغل في الجذور” (ص55)
الأجواء الصوفية بكل تماثلاتها تتجسد في الشك واليقين الذي يحدث لذة فكرية لدى العارفين. - يرى الصوفيون أن العناء يزول حين يذهب الفراق، وحين يحدث التوحد، وكان شاعرنا يرى أن وحدة الحبيبة هي المنتهى (ص32).
- انعكست الثقافة الدينية بكل تجلياتها في معظم قصائد الديوان، وظهرت في تلك النفحات الإيمانية التي عكست تشرباً عميقاً لمعنى النص في جوهره الأخاذ وتضميناته التي تتوسد آيات من القرآن الكريم.
أخيراً، كل ما كتبته هنا لا أعده إلا ملامسة بعيدة تحتاج إلى وقفات المختصين والمحبين.