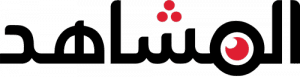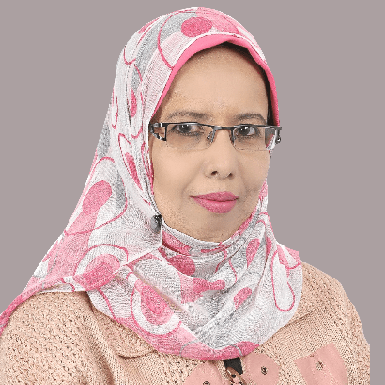قررت السفر إلى مدينة تعز، لرؤية أختي وأبنائها. كنت مشتاقة لتعز المدينة الحالمة كما توصف، لتعز عاصمة الثقافة والمجتمع المدني، خصوصاً وأنني كنت قبل الحرب وحصار تعز أزورها سنوياً، وذلك لرؤية أختي وأهلي، ولزيارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر، ومؤسسة السعيد الثقافية، ورئيسها الأستاذ فيصل سعيد فارع، كما أزور معالمها وأسواقها الشعبية كالشنيني، وباب موسى، وأعود بالجبن البلدي التعزي المميز بمذاقه الخاص، والحُمر (تمر هندي)، والثوم البلدي، وبعض المصنوعات الحرفية الشعبية كهدايا، وألتقي بصديقات مقيمات فيها، في الحدائق والمنتزهات، وأذكر منهن الصحفية فكرة محمود، المحررة بصحيفة “الجمهورية”، ولا أدري ما حل بها، وأين قذفت بها الحرب المدمرة.
بدأت رحلة السفر من صنعاء إلى تعز، الـ10 ليلاً، بالباص المتوسط المسمى “الهايس”، برفقة أحد أبنائي من طلبة الإعلام الخريجين. كان الطريق مملاً وطويلاً، وتتخلله المطبات المفاجئة. وما إن وصلنا ذمار حتى بدأت النقاط الأمنية والتفتيش وأخذ البطائق من الرجال، وبخاصة الشباب، وسؤالهم عن وجهة السفر وأسبابه، وكل منهم يخترع أي سبب حتى لا يتم إيقافه. أما الخريج الذي كان مرافقاً لي، فاعتبرته محرمي، وكنا كلما مررنا بنقطة، طلبوا البطائق الرجالية، كأنهم يريدون أن يلصقوا بهم تهمة ما، بينما نحن النساء لا يعيرنا العساكر أي اهتمام يذكر، لأننا في نظرهم أصلاً غير معترف بنا ككائنات اجتماعية، ولأول مرة لم أحتج على ذلك، واعتبرتها ميزة في مثل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها.
كان السائق يسير بسرعة رغم وعورة الطريق وظلمتها، وهو يتحدث طوال الوقت في هاتفه المحمول، وطوال الطريق كلما واجه نقطة، مد يده بالمعلوم للواقف على النقطة، فيشير له بالانطلاق.
وصلنا “الدمنة” الساعة الـ6 صباحاً، شعرنا بالجوع، ولكن لا حركة ولا مطعم مفتوح، تم إنزالنا من الباص مع عفشنا لسيارة صالون، كي تواصل بنا إلى مدينة تعز عبر منطقة الأقروض. اخترت والمرافق الجلوس في المقعد الأمامي بجانب السائق، وفوجئنا بسائقين يجلسان إلى جوارنا أحدهم يقود السيارة، والآخر بجواره يرد على التلفون، كانا شابين لا يتجاوز عمراهما من هيئتهما الـ16، لم تجدِ معارضتنا لوجود سائقين نفعاً، ووكلنا أمرنا لله.
بدأت السيارة تنطلق بنا في طريق الدمنة، ومنها إلى الأقروض. كان السائق يسير بطريقة جنونية، كأنه في طريق صحراوية. الطريق وعرة وترابية تارة وطينية تارة أخرى، تمر بنا في منحنيات خطرة، وبدت الطريق المستحدثة من وسط الدمنة وحتى الأقروض، مليئة بالمطبات والحفر، تتأرجح فيها السيارة التي تقلنا ذات اليمين وذات الشمال، وعلى جانبي الطريق الملتوية كالثعبان تتناثر الأشجار الجدباء المغبرة، وأغلبها أشجار نمت بفعل السيول التي كانت تجتاح المنطقة أو أشجار الصبار وما شابه ذلك.
الأقروض طريق العطش
حين تنظر إلى تلك الأشجار ينتابك الشفقة عليها ككائن حي، فالجفاف والغبار يحاصرانها من كل ناحية، وتراها تنحني للأسفل وتمد غصونها للمارة لعل أحداً يروي عطشها الذي وصل حتى العمق، ليشقق جذورها. وهناك بعض الأشجار التي لم تتمكن من الصمود طويلاً أمام العطش، فانهارت على قارعة الطريق، ولم يهتم أحد لأمرها.
وتزداد طريق الأقروض صعوبة كلما توغلنا فيها، تصعد بنا السيارة إلى الأعلى، ثم تنزل للأسفل، وتتأرجح بشكل مخيف كأنها ستسقط بنا في هاوية سحيقة.
ولعل ما آلمني، هو منظر الأطفال الذين كانوا يحملون كتبهم متجهين إلى مدارسهم، والشحوب يعلو وجوههم، فتراهم يتعلقون خلف السيارات المارة، غير عابئين بخطورة التعلق، ويحاول بعض أصحاب السيارات منعهم، ولكنهم لا يبالون. فكل همهم أن يصلوا إلى مدارسهم بزمن أقل!
كنت أحدق بنظري في كل الاتجاهات، كي أرى ولو قطرات ماء. انتابني إحساس بالخوف من العطش، فشربت من قارورة الماء التي اشتريتها من طريق إب، وأحكمت إغلاقها. وفجأة رأيت مجموعة من الفتيات والنساء يحملن دبب الماء البلاستيكية الصفراء، ويتوجهن إلى خزانات ماء متوسطة الحجم، ليملأنها. كان منظرهن يوحي بالبؤس، فعلامات التعب والإجهاد بادية على وجوههن، ومع ذلك لم أرَ تدفق الماء، وكن حريصات على عدم هدره من شدة الحرمان، ويبدو أن الماء يأتيهم للخزانات من مناطق بعيدة، وبمبالغ باهظة فوق قدرتهم.
لاحظت أن زراعة القات منتشرة في الأقروض، ولكنه جاف مغبر كالمنطقة، لا يغري بتعاطيه، وترى بين الحين والآخر بقالات صغيرة لمواد غذائية معلبة، أو محلات صغيرة لمستلزمات المطابخ والحمامات. لا يبدو أن هناك مستشفى أو طريقاً معبدة أو معلماً تاريخياً أو مكاناً للراحة.
لم أستطع أن أميز هل الأقروض قرية أم مدينة؟ كانت هناك نسوة منقبات ينتقلن جماعات من مكان لآخر، تحت حرارة الشمس وبين الغبار، وكبار السن يزحفون بين منحنياتها، ويلاحظ أن النقل فيها مازال معتمداً على الحمير، التي يحمّلونها فوق طاقتها.
وتعاني الأقروض، شأنها شأن بقية المدن والقرى اليمنية، من التلوث البيئي المرعب. ولعل أهم ما لاحظته بصورة عابرة، أكياس النايلون التي تغطي بعض الأشجار، وتنتشر على جوانب الطريق.
كانت حركة السير تتوقف لحوالي الساعة، نظراً لاستخدامها خطا؟ في خطين، أي للسيارات القادمة من الدمنة إلى تعز، والعكس، مما ينذر بوقوع حوادث وخيمة في حالة عدم الانتباه، أو تهور بعض السائقين.
أبناء المنطقة يتسمون بالطيبة وعدم معاداة الغريب، فتراهم يقومون من تلقاء أنفسهم بالتطوع لتنظيم حركة المرور، دون أي مقابل.
وكان جزء كبير من الأقروض يتبع المقاومة، وبدأت نقاط التفتيش تأخذ مجرى آخر، وهو التفتيش بالهوية، فمرافقي من إب، أخذوا منه البطاقة أكثر من مرة، وتم التحقيق معه بشأن سبب نزوله تعز، وأين سينزل، و… و…، وما خفف من حدة التحقيق والعرقلة، أنه محرم لي، فأنا خالته..!
كانت الطريق إلى تعز عبر الدمنة والأقروض، ثم المسراخ ونجد قسيم، طويلة ووعرة، استغرقت منا حوالي 5 ساعات، لنصل إلى تعز الـ11 قبل الظهر. وكنا كلما اقتربنا من تعز المدينة، زادت النقاط الأمنية والتفتيش والإيقاف، وكانت النقطة قبل الأخيرة أصعبها، حيث تم إنزال النساء، وتفتيش السيارة بدقة، والتحقيق مع الركاب. ولفت نظري ضابطة أمن منقبة، وتبدو متعلمة، تفتش النساء، والمقاعد، وحين احتجت إحداهن، قالت لهن إن هناك عساكر من جماعة أنصار الله (الحوثيين) يتنكرون بالنقاب، ويدخلون الأسلحة، وإنهم اكتشفوا خلية، وصادروا أسلحة… وكنت أرقب ما تقوم به بصمت.
وكان السائقان قد وضعا تحت البطانيات المفروشة على المقاعد الأمامية، شرائح تلفونات جديدة، في أكياس، وجزء منها وضعوه مع النساء المنقبات، ويبدو أنهن قريبات لهم، وعندما لمحتها الضابطة أخذتها، ولتعزز ظنها فتشت تحت المقاعد الأمامية للسائقين، فوجدت شرائح أخرى، فسلمتها للضابط، ونزل السائقان، وتفاهما بطريقتهما مع الضابط، ورجعا كأن شيئاً لم يكن، مؤكدين لنا أنها شرائح خاصة بمحل في تعز، ومعهما فاتورة بذلك.
استحداثات أمنية وخراب في الشارع الخلفي، كأن الحرب مازالت مشتعلة، فقيل لي: هذه منطقة تماس ما بين المقاومة والحوثيين، على بعد أمتار من بيت أختي.
تعز لم تعد الحالمة
خرجت في اليوم التالي، وكان يوم جمعة، وكنت مدعوة على الغداء مع أختي وبناتها، عند صديقة لي تسكن في منطقة صالة، واستأجرنا باصاً معروفاً، لأن لا باص أجرة يوافق على الدخول لتلك المنطقة، فهي في خط التماس أيضاً ما بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) والشرعية (المقاومة). وفي الطريق إلى صالة، أشار السائق إلى بيت إحدى قريباتي التي نزحت إلى القرية منذ حصار تعز، كان مدمراً تماماً.
بدت المدينة كأنها مهجورة في ظهر الجمعة، وأكثر العمارات عليها آثار الدمار، فالجروح تغزو كافة أجزائها، ونوافذ الكثير منها محطمة، وبعضها مهجورة، وقد تهدم جزء منها. ولعل الأمر المؤلم أن تجد عمارة مؤلفة من طابقين، الطابق الثاني دمر تماماً، ولم يبقَ سوى جزء من السقف، ومع ذلك تجد عائلة مستوطنة فيه.
لاحظت أن حركة البناء مستمرة، في مختلف الأماكن، وهناك عمارات تم تهديمها تماماً، وإعادة بنائها من جديد، بناءً يبدو مكلفاً جداً، وبعض البنايات يبدو أن تجار الحروب إما بسطوا عليها بعد هروب أهلها من نيران الحرب، أو رحيلهم من حياتنا الفانية، أو أنهم باعوها برخص التراب، أو تم إجبارهم على ذلك نتيجة العوز والفقر.
وفي طريق العودة قبل المغرب، أشار لنا السائق إلى أن الجهة المقابلة تحت سلطة أنصار الله، وأن القذائف والقنص وتبادل إطلاق النار مازال مستمراً، وشبح الحرب والصراع مخيم على مدينة تعز التي لم تعد حالمة.
دأت معالم مدينة تعز تتغير، وانتصبت العمارات الإسمنتية، وهناك فندق جديد استحدث والأضواء تتلألأ عليه، ورغم الدمار فإن الناس يمارسون حياتهم الطبيعية، كأنهم اعتادوا عليها.
عدت إلى بيت أختي، وكنت في أشد القلق على مستقبل مدينة تعز التي تقاوم الفناء بإصرار عجيب، وحاولت النوم مبكراً، لكن صوت المدافع والرصاص يخترق أذني طوال الليل وحتى الـ5 فجراً، بينما أختي وبناتها يغططن في نوم عميق لم يسمعن شيئاً.
قلت لأختي لا مكان لك هنا، فالبيت إيجار، شدي الرحيل إلى صنعاء، جهزي حقائبك، حتى إذا اشتد الصراع اخرجي منها، قالت ببرود: لن يحدث شيء، خليها على الله.
وفي الصباح قيل لنا إن هناك جرحى وقتلى من المدنيين حوالي 13 شخصاً، وأباً وابنه تم قنصهما، ومع ذلك كانت الحياة تدب بالحركة، وكل في حال سبيله.
توجهت مع مرافقي إلى محطة السيارات الصالون المتجهة إلى الدمنة، ولأول مرة أشعر بغربة عن تعز، فمن فيها معظمهم لا يشبهونها، انتظرنا في إحدى السيارات أكثر من ساعة، حتى تم حشرها بالركاب، فوق طاقتها، فالكرسي المتسع لاثنين يحشر فيه 3 ركاب، ومن يريد معقداً لا يزاحمه فيه أحد، يدفع أجرة مقعدين!
كنت في حالة استنفار، لا أريد البقاء في تعز التي استوطن فيها القتلة وتجار الحروب، وحاصرها الفقر والمرض، رغم ما يعتصرني لما ألم بها. فجوار بيت أختي امرأة فقدت اثنين من أبنائها في عز شبابهما، أحدهما كان ناشطاً ومتطوعاً مدنياً لإنقاذ المصابين من المدنيين، والآخر كان طالباً بكلية الطب، أصابته رصاصة ربما طائشة أو مقصودة.
أتدورن، أعزائي القراء، أنني أكتب إليكم بحبر دامٍ، وقلبي يتمزق حزناً على تعز واليمن ككل، فهل يوحدنا “كورونا”، أم سنظل نخرق السفينة بأيدينا، لنغرق جميعاً؟!