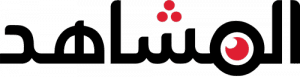طغى في الفترة الأخيرة، في المجال العام اليمني، النقاش والجدل حول الشعبوية والبذاءة وتعالي النخبة، وبين المفاهيم الثلاثة، ضاع الكثير مما ينبغي أن يكون المقصود، وصار الجميع يخوض معارك مع طواحين الهواء المتخيلة.
في البدء، ما هو المقصود بمفهوم الشعبوية الذي طرأ متأخراً، والذي ربطه الكثيرون بالبذاءة، رغم أن كثيرين ممن وصفوا بالشعبوية، لم يصدر منهم أية شتائم أو بذاءات، وأبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يعبر عن يمين متطرف، أو الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، وهو من اليسار، فما الذي يجمع بينهما؟ بحسب كثير من التعريفات للمصطلح الجديد والغامض؛ الذي يجمع بينهما، هو الخطاب الجماهيري العاطفي الذي يرفع من حدة الاستقطاب، فمن معي هو الشعب، ومن ضدي دخيل على الشعب النقي والوطني، وكذلك احتقار كليهما للعمل السياسي المؤسسي.
بالمناسبة، هذا تعريف قد ينطبق على بعض الحركات الثورية والقومية والقيادات المبجلة في منطقتنا، بخاصة في مرحلتي الستينيات والسبعينيات. لكن مع رسوخ قواعد الحياة السياسية الديمقراطية في بعض الدول، وتقاليدها المؤسسية، يصبح من الممكن التمييز بين الشعبوي والسياسي، وهذا أمر غير وارد في حالتنا.
إضافة إلى الحرب في اليمن بعد تقويضها معظم ملامح الدولة التي حلت محلها سلطة مليشيات تعتمد سياسة التحشيد الجماهيري بالشارع، والتي صارت بديلاً عن السياسة التي انسدت أبوابها بفعل العنف، مما يفسر قلق جماعة مثل الحوثي من أي شكل من أشكال التجمعات الشعبية، حتى لو لم تكن معارضة لها، بل تتماهى مع مشروعها في تغييب وعي المجتمع، والتحريض على النساء، وغيرها من مضامين بائسة في إطار أقل ما يقال عنه بالقبيح لافتقاده ليس فقط الجمال، بل أيضاً الموهبة والمتعة.
مصطلح الشعبوية غامض وجديد، ومقتصر على السياسة في مصدره القادم من الغرب، وهو مصطلح مشابه في اشتقاقه اللغوي لمصطلح الإسلاموية، الذي صعد مؤخراً في وصف التيارات الإسلامية التي يصنفها الغرب بالراديكالية، رغم أنه لا يوجد شيء مشابه لهذا مع الحركات الدينية المتطرفة الأخرى في المسيحية والهندوسية مثلاً.
هكذا امتد استخدام مصطلح الشعبوية لدينا، ليشمل ظواهر ثقافية، لم يكن المثقفون اليمنيون هم المثقفين العرب الوحيدين الذين يوصفون بها ظاهرة ثقافية يرونها مرادفاً لما كان يطلق عليه سابقاً السوقية أو الابتذال أو البذاءة، وهي مفردات صعب الاتفاق عليها.
السؤال هنا: لماذا هذا القلق من هكذا ظواهر تأخذ حجمها وتنتهي سريعاً مهما تضخمت بشكل مبالغ فيه، بل بعضها بمرور الوقت تصبح ظاهرة عادية؟ مثلاً مسرحية “مدرسة المشاغبين” أثارت ضجيجاً كبيراً وقت عرضها في ما يتعلق بمضمونها الذي يسيء لمكانة المدرسين.
في الواقع، المسرحية كانت صرخة جيل جديد متمرد، فلأول مرة يقدم مسرح لا يحمل مضامين الرسالة الأخلاقية المباشرة للجمهور. مع مرور كل هذا الوقت على المسرحية، يمكن القول إن تدهور مكانة المدرسين لم يكن سببه المسرحية، بل سببه سياسة الدولة وتدني أجور المدرسين وانتشار الدروس الخصوصية.
الإِشكالية ليست في شعبية ما يقدم، ولا في محاولة حراسة أخلاق المجتمع وذائقته، حسبما يفترض، بل في انحسار كل ملامح الإنتاج المعرفي والثقافي في اليمن بالإنترنت، مع اهتمام بسيط تبديه قنوات التلفزيون اليمني بإنتاج محدود، بما فيها تلك القنوات الموجودة في الخارج.
الناس ملت من السياسة، وصارت تميل بشكل متزايد نحو التعاطي مع الترفيه والمتعة في ما تريد التعرض له عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا مفهوم، لكن اقتصار الترفيه والمتعة بكل أشكاله مثل الغناء والرقص والمسرح والشعر وغيرها، على منصات التواصل الاجتماعي، يخلق كثيراً من الظواهر التي قد تكون سطحية وبائسة.
منصات التواصل الاجتماعي بطبيعة تكوينها، وحسب القائمين عليها، تقوم على فكرة جذب المستهلك للمزيد من الوقت للبقاء فيها، وبالتالي هي تقترح ما هو جذاب وشعبي، هكذا يصبح الشتم والإيحاءات الجنسية وسيلة جذب ترفع من نسب المشاهدة والحضور.
هذه حالة موجودة بكل العالم، فبالتأكيد عدد مشاهدي الموسيقى الكلاسيكية أقل بكثير من المشاهدين لأغانٍ شعبية قد تكون مليئة بالشتائم، لكن تظل الإشكالية في اليمن أن المتوفر والموجود بالساحة هو فقط من الصنف الجذاب والخالي من أية قيمة فنية حقيقية.
إنتاج أي محتوى معرفي أو عمل فني يتطلب بيئة متكاملة، مثل مجهود فريق وتمويل، ومكان للتجمع والعمل، وهذا كله صعب في بلد تقطعت أوصاله، وصار أسير جماعات متطرفة ومتوجسة من الفن والثقافة أكثر من شيء آخر، لذا صار المتنفس الوحيد هو مقطع يوتيوب ساخر أو منشور فيسبوكي أو غيره من إنتاج لا يتطلب أكثر من مجهود فردي.
ففي أمريكا مثلاً تنزل آلاف الفيديوهات يومياً في اليوتيوب، بشتى أشكال المحتوى المعرفي والترفيهي، وفي إطار الموسيقى فقط سنجد تنويعات تتراوح بين موسيقى الهيب هوب للسود التي لا تخلو فيها أغنية من ألفاظ نابية وشتائم، إلى موسيقى كلاسيكية، وما بينهما الكثير، بينما في اليمن لا ينتج جديد إلا في ما ندر، وفي ما عدا ذلك تكرار للقديم.
تصحر المجال الترفيهي والثقافي هو السبب في الطغيان المطلق لهذه المحتويات، حتى أصبحت بلا منافس، لأننا نعتمد على وسيلة بطبيعتها استهلاكية وتجارية خالصة. صحيح أن إشكالية الربح في وسائل نشر المعرفة والترفيه، حاضرة دوماً، لكن لوسائل التواصل الاجتماعي خصوصيتها في كونها منصة قلما يتحكم بها العنصر البشري، مما يزيد من فداحة هذه المشكلة.
ليس هذا فقط، فوسائل التواصل الاجتماعي صُممت تقنياً بطريقة تمكنها من معرفة توجهات كل مستهلك، واقتراح ما يناسبه، بالتالي يظل كل فرد يدور في دائرته الخاصة، دون تنوع أو حتى تعرض لأمر خارج نطاق ما تعرض له مسبقاً أو لمعارف من خارج دائرته.
أي أن وسائل التواصل الاجتماعي منصة ضيقة على اتساعها، والاعتماد عليها في المجال الثقافي لأي بلد، يعني عدة أمور:
1- انقسام جمهورها ومثقفيها، لأن لكل مجموعة دائرتها التي تتحكم بها إدارة هذه المنصات.
2- محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مهما حاول البعض الصعود فيه، أو تطويره، يظل محكوماً بالسرعة والسطحية والجذب، فالأكثر مشاهدة يزيد عدد مرات اقتراحه، وبالتالي يزيد عدد المشاهدين، وهكذا في دائرة صعب اقتحامها.
بالتالي، هي منصات تزيد من إشكالية الشللية التي طالما كانت إحدى أبرز السمات السلبية للنخبة اليمنية المثقفة، وهذا يؤكد حقيقة أنه لا شيء يستطيع تعويض غياب المنصات التقليدية من منتديات ومسارح ومكتبات ودور سينما وحتى مقاهٍ.
لهذه المنصات عيوبها القاتلة، ولكل أداة إعلامية عيوبها، فمثلاً عندما ظهر التلفزيون نظر له الكثيرون كشر مستطير، وأنه سيوقف الناس عن القراءة والمعرفة، لكنه تحول في النهاية كغيره منصة ضمن منصات عديدة للمعرفة والترفيه.
كذلك وسائل التواصل الاجتماعي فتحت المجال واسعاً للجميع لطرح ما لديهم، بعد أن كانت الجرائد والمجلات تقتصر على أسماء معروفة من الكتاب تبرزهم وتنشر لهم. هي مساحة واسعة مفتوحة للجميع لا يحتكرها مثقف أو صاحب معرفة أو شخصية معروفة.
تحمس بعض الكتاب والمثقفين لمهاجمة الشخصيات الصاعدة، وكان معظم النقد موجهاً للبذاءة، ووصمها بالشعبوية، وكانت معظم الردود من كثيرين، أن هذه مبالغات “عميقين” “مثقفين” “يسمعون موزارت، ويشربون قهوة”، وغيرها من توصيفات ساخرة عن المثقفين، وكلها تدور حول فكرة أنهم “بعيدون عنا”.
الناس هنا ضد نقد أشخاص يشبهون غالبية المجتمع في اللبس وتعاطي القات، بل في شتائمه أيضاً، وهذا كان محور النقد الذي خلط بين مضامين ساخرة مختلفة، بعض هذه المضامين يخدم سلطة الحوثي ومفاهيمه الاجتماعية، وأخرى مقاومة له، بل تركز هذا الهجوم على نقد الشتائم وظواهر اجتماعية شائعة مثل القات، رغم أن منصات التواصل الاجتماعي أدوات شعبية، وليست نخبوية، وكما نعلم الشتيمة هي جزء أصيل من التعبير الشعبي، ويتضح من أمثالنا وأغانينا ونكاتنا، مع التمييز بين الشتم كلفظ مختلف عن التشهير والقذف الذي قد يقع بدون شتائم، والشتيمة هي سلاح ذو حدين يجذب وينفر.
محاولة التصدي لحالة جماهيرية غير سياسية، فنية على سبيل المثال، كمحاولة منع “أغاني المهرجانات في مصر”، دائماً تعطي نتائج عكسية، فالمجتمع أكبر ديكتاتوري في ما يهواه، ويكره من يحاول تقويمه أو فرض وصاية على ما يخص مزاجه وذوقه، رغم أنه قد يتسامح مع من يحاولون فرض حكمهم وسطوتهم.
هكذا ظواهر تستدعي الفهم والتفسير، وليس الإدانة، وهي ليست مقلقة لو كانت في بيئة تنتج جميع أشكال المعرفة والثقافة من هابط لراقٍ، بالتالي لا يعتري نخبها الفزع من كل الظواهر الشعبية التي قد تختلف مضامينها من جيدة وذكية تستحق الاهتمام، إلى بائسة ومبتذلة.