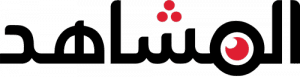اعتدت في يوم 18 ديسمبر أن أكتب خاطرة بمناسبة يوم اللغة العربية، أو ذلك اليوم المخصص عالميًا أو عربيًا للاحتفاء باللغة العربية. أعيش في منفاي الفرنسي، وأتعامل مع اللغة العربية بخليط من التعصب والحب، من الحنين وتأنيب الضمير، لأنها تنثال بين يدي أولادي في بلاد تجتهد إدارتها كي لا يتحدث الغرباء بغير لغتها.
لكني هذه المرة لم أفعل. فقدت حماسة الاحتفاء في ضجيج أكبر من أي بهرج وطقطقة طبل. بيد أني تابعت -بقدر ما تسمح به حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي- ما كتب من تدبيج أو ذم، من تقديس أو حط لهذه اللغة. واهتمامي بهذه الوسائل ينبع من كونها واسعة الانتشار وتتدفق فيها آراء ومعلومات كثيرة دقيقة وغير دقيقة يمتد نطاقها من أكثر الجوانب الحميمية في الفرد إلى قضايا العقيدة والهوية السياسية وآخر اكتشافات الفضاء.
وهي تتنوع بين مقولات ذات طابع استبطاني فردي أو ملفوظات دعائية اللون محكمة البناء نافذة الأثر وأمضى سلاحًا.
لم أكتب ما يجول بخاطري يومها، وبعد يومين تحدثت إلى صديق يتنقل بين النمسا والبلدان العربية، لا سيما السعودية، ويتعايش مع ثلاث لغات بشكل دائم. نشترك باهتمامات جيوبوليتك، وجمعتنا تشوهات المهنة، فانصب حديثنا عن دور اللغة العربية في تماسك المجتمعات التي تتحدث بها أمام السياسات الاستعمارية، بينما مجتمعات أخرى لديها لغات مماثلة، ويتحدث بها ملايين، لكنها استسلمت واتخذت من لغة المستعمر لغة رسمية على حساب لغاتها المشتركة، ثم لم تلحق بالحداثة، ولا قطعت مشاوير طويلة في التنمية والتحديث، إنما غدت تعاني من قطيعة مع ذاتها طالما يتواصل أبناء البلد الواحد بلغة المحتل، ويدرسون بلغته، ويصيغون قوانينهم بها.
دور اللغة العربية في تماسك المجتمعات التي تتحدث بها أمام السياسات الاستعمارية، بينما مجتمعات أخرى لديها لغات مماثلة، ويتحدث بها ملايين، لكنها استسلمت واتخذت من لغة المستعمر لغة رسمية على حساب لغاتها المشتركة
استندت في حديثي معه إلى واقع مشاهداتي اليومية ومواقف عشتها في مغتربي واحتكاكي بأناس من شمال ووسط وغرب إفريقيا تحديدًا. بل إن حادثة بعينها هي التي قدحت شرارة تلك الملحوظات، إذ قبلها بأيام قابلت صديقي زكري في ساحة اسمها ساحة أوروبا. ويا للصدفة أن تكون ساحة باسم فضاء سياسي يرفع من شأن اللغة أو اللغات، ويتحاور فيه سبعة وعشرون عضوًا كل بلغته دون كلل ولا ملل.
وصديقي زكري هذا بوركينابي الجنسية، يعمل في متجر باكستاني أشبه بمغارة علي بابا حرفيًا، حيث يباع فيها كل شيء من وصلات الشعر الإضافي القادم من البرازيل، إلى فخار الطاجين المغاربي، وانتهاء بقسم الجزارة واللحوم الطازجة في مساحة 18 مترًا مربعًا.
جلست إلى جوار صديقي أرتشف قهوتي من كوب ورقي، وتبادلنا التحايا. والاسم زكري أو زاكاري هو اختصار لـ”زكريا”. وقد تعرفت عليه من ملعب الحي، حيث نتجمع ونلعب كرة القدم، وهو ماهر في اللعب لا يبارى.
كان حديثي معه بالفرنسية، لكن شخصًا آخر إفريقيًا مر بنا، وجذب زكريا إليه في حديث بلغة لا أفقه منها شيئًا، ثم ودعنا.
سألت رفيقي: هل صديقك هذا من بلادك؟ أجابني بالنفي، وأنه من بلد آخر مجاور، لكنهما يتكلمان لغة مشتركة. قادنا الحديث إلى شأن لغات الغرب الإفريقي، وأعلمني أن بلدانًا عديدة تشترك بلغة واحدة محلية كالولوف أو الإيويه والبامبارا، وهي لغات من عائلة المانديه، حيث يتكلم شعب بلد واحد لغات عدة. لكن معظم هذه البلدان اتخذت لغة المستعمر أكانت الفرنسية أو الإنكليزية أو البرتغالية، لغة رسمية لعموم سكان البلاد. وشيئًا فشيئًا تذوي اللغات الأم، خصوصًا تلك غير المكتوبة، والتي تقوقعت في الأرياف، وبات المتكلمون بها أقل فأقل، حتى إن الجد لا يتحدث بها مع الحفيد كما أوضح لي.
العربية متصلة بالعقيدة الدينية (إسلام أو نصرانية)، وهذا التواشج بين اللغة والعقيدة كان عامل صمود أمام التجريف اللغوي والثقافي الاستعماري
لم تكن اللغة تكفي لتشكل عنصر مقاومة ثقافيًا كبيرًا. وهذا لا يعني أن تلك البلدان لم تقاوم ثقافيًا. بل العكس، توغلت هي أيضًا في لغة المستعمر، وغزته بفنونها، وأثرت مفرداتها وأدبها من ناحية، أو أنها استملكت اللغة القادمة ومزجتها بلغاتها، وجعلت منها شكلًا جديدًا يطلق عليه في باللغة المولدة.
العربية متصلة بالعقيدة الدينية (إسلام أو نصرانية)، وهذا التواشج بين اللغة والعقيدة كان عامل صمود أمام التجريف اللغوي والثقافي الاستعماري. ولعله ما لم يكن متوفرًا في لغات بعض هذه الشعوب، وإن كان البعض منها يدين بالإسلام أو المسيحية أيضًا على سبيل المثال.
أمام تركة استعمارية ثقيلة، لا بد من أن تظهر مشكلة اللغة إلى السطح ما إن فكرت هذه الشعوب بالانعتاق من الوصاية الاستعمارية، ولا تجد فكاكًا هينًا.
وقفت مع نفسي أنظر إلى العربية، وأتأمل في أقوال بعض العرب، مما يلقون على مسامعنا أنها لغة عسيرة متهاكلة، وهي لغة أيسر بناء صوتيًا وإملائيًا من غيرها. لكني قبل يومين شاهدت مقطعًا مصورًا عن اللغة الفرنسية يتحدث فيه شخصان، هما أرنو أويت Arnaud Hoedt وجيروم بيرون Jérôme Piron، في ملتقى تيديكس مدينة رين الفرنسية، عن مسألة احترام قواعد الإملاء في اللغة الفرنسية، ويضعان سؤالًا بسيطًا:
إذا كنا مطالبين باحترام قواعد الإملاء (في اللغة الفرنسية)، فهل قواعد الإملاء تحترم نفسها؟
وذكرا أنهما طورا برنامجًا حاسوبيًا وفق قواعد الإملاء الفرنسية وطلبا منه كتابة كلمة ابتكراها ليعرفا ما الطرق الممكنة لكتابة تلك الكلمة. كانت الكلمة المبتكرة هي كرييفيسيون التي قد تكتب هكذا creffession أو صوتيًا krefesjɔ̃. ووجدا، على نحو صادم، أنه يمكن كتابتها بـ240 طريقة وفق النظام الصوتي وقواعد الإملاء بالفرنسية. ما ينطبق على اللغة الفرنسية قابل للتطبيق على لغات أوروبيّة لاتينية أو جرمانية أيضًا.
ذكرني المقطع بأقاويل من يريدون استبدال الحرف العربي بحرف لاتيني، أو إلى تركها لأنها بالية معقدة كما يقولون. ليست المشكلة في اللغة ذاتها، ولكن في مستوى مستخدميها العلمي والمعرفي، وحرصهم على استعمالها والتزود منها. فاللغة الفرنسية صعبة واسعة المفردات، لكن الفرنسيين يحسنون استعمالها حتى في كل تفاصيل حياتهم اليومية. وهناك سياسة إعلامية صارمة في جل القنوات ومحطات الإذاعة لاستخدام لغة فرنسية رفيعة جزلة.
لا يتحرجون من استخدام القديم والأمثلة الغابرة، ويحيون اللغة يوميًا. الناطق بها يستشعر لذة هذا الاستخدام. حتى في كلامهم مع أطفالهم يخال لك أنك في قاعة محكمة أو في نقاش في الأكاديمية (المجمع اللغوي)، لفرط ما ستسمع من صور وتشبيهات وخلق معانٍ إلى درجة التكلف. فلا عجب أن تنال فرنسا حصة كبيرة من جوائز نوبل للأدب.
هذا لا يعني أنه لا توجد مستويات في اللغة، وأن هناك لغة مقلوبة تمامًا (قلب الكلمات حرفيًا)، وتصحيف وتحريف وسوء نطق وفقدان قواعد. لكن المؤسسة الرسمية متمسكة بتقاليد لغوية فخمة، وتغرسها مدرعة بالقوانين واللوائح. وقبل هذا بروح ابتكارية. هناك كوميديان فرنسيون عندما تشاهدهم أو تستمع إليهم كأنك تتصفح المعجم. بل إن صنعتهم هي المعجم عينه.
إني أتطلع إلى يوم تغدو العربية فيه قسمًا محلوفًا، فنقول: وعظمة العربية! أو وحياة العربية!