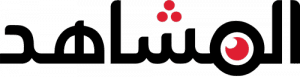ازداد شعوري بنكبة المشهد الثقافي حين قرأت مقابلة أخيرة مع الروائي اليمني علي المقري، في مجلة “عالم الكتاب” المصرية، عدد 76، إذ إنه قال: “من الصعب القول إنه يوجد مشهد أدبي في اليمن. في ظل ظروف الحرب صار كثيرون من الأدباء يبحثون عن لقمة العيش، وعن إمكانية العيش ولو بحدها الأدنى. فلم يعد هناك إمكانية لوجود كتابة أدبية في ظل القصف من الأرض أو من الجو”. والواقع أن اليمن أصبحت للمبدع نشاطًا للقلق، فلم تعد الزهور منظرًا يمكن الالتفات إليه أو إعطاؤه مساحة للتأمل، حيث أصبح النظر إلى مثل هذه الأمور شيئًا من الترف، أما أن تتحدث عن شيء اسمه القمر، فحدث ولا حرج، فإن الحديث عن مثل هذه الأمور مدعاة للتندر والسخرية، لم يعد منظر القمر شيئًا مسليًا في الصيف ولا في الشتاء، وكذلك النجوم التي كان تتبعها يعني استدعاء الخصب والنماء ومواسم الخير والزراعة، لم تعد سوى ثقوب سوداء لجلب الرصاص.
ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستمتاع بالنظر إلى السماء، لأن ذلك شيء من الترف –أيضًا- وصف وجدي الأهدل السماء في روايته الأخيرة بلغة تهكمية من أنها تدخن سجائر، ولا تمطر إلا قتلًا، وفي كثير من مقاطع الرواية يتحدث الأهدل عن معاناة سكان المدن اليمنية أثناء الحرب، وكيف أن الكتل البشرية النازحة حين تنتقل إلى مكان بعيد داخل المدينة أو خارجها، لا تجد سوى الموت أمامها. في هذا المقطع يقول: “تواردت الأنباء أن الداهية التي ضربت جبل نقم هي قنبلة نيوترونية يبلغ مداها عشرة كيلومترات، وأن عدد ضحاياها قد بلغ 120 قتيلًا و400 جريح، وتضرر أكثر من عشرين ألف منزل” (الرواية ص65)، بمعنى أن كل ما كان مصدرًا للبهجة أصبح مصدرًا للرعب، وعُدّ كل ذلك كما لو أنه خذلان جهنمي تتشاركه السماء مع الأرض.
ملاحقته وإقصاؤه لمجرد الخوف من أنه يحمل قلمًا أو بطاقة عضوية في نقابة الصحفيين أو بطاقة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كما حدث مع كاتب هذه السطور أثناء دخولي إلى مدينة عدن، حيث عثر الجنود في حقيبتي على بطاقة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وعلى الفور ارتعد وجه المفتش، وبدلًا من أن أدينه لأنه انتهك خصوصيتي، وقلب في أوراقي الشخصية -وهو يعرف أنني لا أحمل سلاحًا- أدانني هو، مستغلًا وظيفته التي تشرع له ذلك
هكذا يمكننا أن نقول إن المبدع جزء من هذا السياق، تأثر بشكل بالغ بما حدث، وتمت ملاحقته وإقصاؤه لمجرد الخوف من أنه يحمل قلمًا أو بطاقة عضوية في نقابة الصحفيين أو بطاقة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كما حدث مع كاتب هذه السطور أثناء دخولي إلى مدينة عدن، حيث عثر الجنود في حقيبتي على بطاقة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وعلى الفور ارتعد وجه المفتش، وبدلًا من أن أدينه لأنه انتهك خصوصيتي، وقلب في أوراقي الشخصية -وهو يعرف أنني لا أحمل سلاحًا- أدانني هو، مستغلًا وظيفته التي تشرع له ذلك، فوجه لي عديدًا من الأسئلة مباشرة: هل أنت صحفي؟ ومع من تعمل؟ وماذا ستعمل في عدن؟ وحين أخبرته أن هناك فرقًا بين بطاقة اتحاد الأدباء والكتاب، وبين بطاقة نقابة الصحفيين، لم يفهم ذلك، الأمر الذي جعله يتخذ قرارًا بإحالتي إلى مرؤوسه في النقطة، وهناك تم إعادة نفس الأسئلة، وقد أنقذني أن البطاقة مكتوب فيها أمام حقل مجال اهتمامي: “قاص” -كاتب قصة قصيرة.
يحس المثقف أو المبدع أنه نبتة تتغذى على الفجائع والهموم، وأنه نبتة غريبة نمت في تربة ليست تربتها.
ليسألني ماذا تعني مفردة قاص؛ فأخبرته أنها تعني كتابة الروايات والقصص القصيرة، ثم قال لي المهم أنك لن تكتب عنا، فقلت له ليس في بالي أي مشروع لكتابة قصة، وفهمت من تعليقه الأخير أنه إنما أراد أن يبرر عملية استجوابي، التي لم تكن ضرورية.
وأمام كل ما يحدث، يحس المثقف أو المبدع أنه نبتة تتغذى على الفجائع والهموم، وأنه نبتة غريبة نمت في تربة ليست تربتها.
أن أمر ضربة وُجهت للمشهد الثقافي اليمني: هي القطيعة بين الأجيال، فإذا كنّا نشكو من وجع القطيعة مع الجيل الممهد لثورة 26 سبتمبر، فإننا اليوم نشكو من القطيعة مع جيلين، ما يعني أننا اليوم لدينا جيل واسع على امتداد اليمن يعيش على قطيعة تامة مع الأجيال، وذلك بسبب الضربة التي وجهت للتعليم
ومما نكد عليّ وأرعبني قبل أيام، أنني التقيت في القاهرة بشابين يمنيين يهيمان على وجهيهما.. ويبدو عليهما القلق والحزن والألم المركب، وقد عرفت منهما أن قضيتهما تتعلق بعملية رأي؛ فقد تم احتجازهما مع آخرين قبل ثماني سنوات، حين كانا يهربان من ضربات الطيران الحربي، كباقي أبناء الشعب، وقد صادف أنهما انتقلا إلى أحد الفنادق بحثًا عن الكهرباء التي انقطعت نهائيًا، في 2015، عن مدينة صنعاء، وهذا العمل كلفهما البقاء ثماني سنوات في السجن.
ما أود التأكيد عليه اليوم، هو أن أمر ضربة وُجهت للمشهد الثقافي اليمني: هي القطيعة بين الأجيال، فإذا كنّا نشكو من وجع القطيعة مع الجيل الممهد لثورة 26 سبتمبر، فإننا اليوم نشكو من القطيعة مع جيلين، ما يعني أننا اليوم لدينا جيل واسع على امتداد اليمن يعيش على قطيعة تامة مع الأجيال، وذلك بسبب الضربة التي وجهت للتعليم، فالمدرسة هي همزة وصل بين الأجيال، وهذه الوسيلة المفصلية تم تغييبها واستغلال ما تبقى منها بعيدًا عن الذاكرة الوطنية.
يقول أحمد القصير، في كتابه “إصلاحيون وماركسيون –رواد تنوير اليمن”، صادر عن المجلس الأعلى للثقافة، 2016: “يعتمد تطور المجتمع ونهضته على تواصل الذاكرة الاجتماعية، وعدم تعرضها للانقطاع. كما تنطوي عملية التواصل على الوعي بذاكرة المجتمع، وتمثل دلالتها. ونعني بتلك الذاكرة كل ما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي، بما في ذلك الشرائح والطبقات الاجتماعية والثقافة والفكر وكافة أشكال الإبداع” (ص91).
ماذا يعرف هذا الجيل عن أحمد محمد نعمان، رائد الحركة التنويرية؟ وماذا يعرف عن موروثه الفكري والسياسي والأدبي، وعن دوره في التأكيد على أهمية المدرسة للخروج من عصور الظلام إلى العصور الحديثة؟ ماذا يعرف هذا الجيل الذي يقع اليوم –مثلًا- بين سن الـ15 والـ25، عن أبي الأحرار محمد محمود الزبيري، وقصة نضاله التي حرمت من تجسيدها في مناهج التعليم وفي التلفزيون والسينما والإذاعة والصحافة؟ بالتأكيد لم تأخذ حقها، ومن حق الجيل الجديد أن يطلع على الحقيقة الغائبة.
من تابع المشهد الثقافي في مصر هذا العام، سيدرك أهمية الدولة المتنورة التي تضطلع بمهامها في إرساء قيم الثقافة الوطنية، فحين اجتمع القائمون على الشأن الثقافي المصري تساءلوا ما الذي يمكن إضافته لأعمال طه حسين؟ يقول طارق الطاهر، رئيس مجلة الثقافة الجديدة، في عدد 397 أكتوبر 2023م، خاص بطه حسين: “ما الذي يمكن أن يكتب عنه؟”، ويضيف في ذات الوقت: “إدراكًا جديدًا بهذه الشخصية الاستثنائية في تاريخ الإنسانية، التي مثلت في لحظة ما أمل الأمة” (ص5). وقد كانت المفاجأة أن معظم دور النشر والمؤسسات المصرية مثل: قصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية للكتاب، أعادت طباعة كتب طه حسين وبعض مما يتعلق بها، في خطة تنويرية بعثية، وكانت المفاجأة الكبرى أن الجيل الجديد، وبخاصة طلاب المدارس والجامعات، أقبلوا بنهم على كتب طه حسين، وهذا المؤشر تم رصده من خلال معرض الكتاب الدولي الـ55 الذي أقيم في القاهرة في يناير -فبراير الفائتين، ويمكننا اليوم أن نتساءل: إذا أعيدت طباعة أعمال النعمان والزبيري ومحمد علي لقمان ولطفي أمان والبردوني وحنبلة وجرادة وعبدالولي، كيف سيتم استقبالها؟ هل سيتم الإقبال عليها، أم أن السياق قد اختلف؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟
وإذا كان لي هنا من لوم، فإنني أوجهه إلى وزارتي الثقافة والجهات المعنية في كل من صنعاء وعدن، وإلى الجهات المعنية التي أعتب عليها بسبب غياب الاهتمام بالكثير من الرموز الوطنية التي تساقطت بين 10 و15 عامًا، دون أن تقام لها حتى أربعينية. وللتذكير فمن هؤلاء رائد الفن التشكيلي الحديث هاشم علي، والمفكر أبو بكر السقاف، والناقد عبدالله علوان، والأديب عبدالرحمن عبدالخالق، والشاعر حسن اللوزي، والشاعر عبدالرحمن فخري، والمثقف والمفكر الكبير هشام علي بن علي، ومؤخراً الناقد محمد ناجي أحمد، والتشكيلي ياسين غالب، ومحمد صالح حيدرة، والقائمة للأسف طويلة.. إن نسيان مثل هذه الكوكبة سيعمق تغييب الذاكرة الوطنية، ويمحو أثر الحلم بمجتمع حديث. وحتى لا تتغول الذاكرة المفترسة، وتسود المجتمع اليمني “ذاكرة السمكة” التي تفقد عقلها كل ثانيتين.. حتى لا يحدث ذلك، ويصبح هؤلاء القامات بخارًا تذروه الرياح، وحتى لا تتصحر حياة الأمة، لا بد من إنشاء مؤسسات وقصور ثقافية ومراكز بحثية ومكتبات حديثة في كل محافظة ومدينة يمنية.