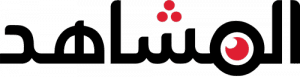لعمري إن من الأمور التي تؤرقني وتؤرق معظم أبناء الوطن -خصوصاً الأنقياء منهم الذين لا يؤمنون بجدوى الحروب، وإثارة الفتن والاتجار بالبشر- قضية التعليم والمناهج المدرسية في بلادنا، وما تتعرض له من عبث يندى له الجبين، جيل بأكمله يتخبط في حيص بيص الأيديولوجيا الحربية، وتقلباتها المزعجة حدّ الفزع؛ حتى بتُ أؤمن أن عدم الذهاب إلى المدارس أفضل من الذهاب إليها في هذه الآونة التي رافقها ظهور حروب جائرة ما أنزل الله بها من سلطان؛ في حق هذه الشريحة المظلومة بكل لغات الدنيا، والواقع أنه قد تأثر جيش جرار من الأطفال والتلاميذ والطلاب جراء الحرب المدمّرة في اليمن، إذ يقترب عدد المتضررين من الحرب من 6 ملايين متعلم أو راغب بذلك؛ منهم مليونا طفل كانوا يستعدون للالتحاق بالمدارس، لكنهم تشردوا؛ أو يُتموا، أو دمّرت مدارسهم القريبة من بيوتهم، أما الآخرون فيقدرون بـ4 ملايين طالب وطالبة، بمن في ذلك تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات الذين دمرت كلياتهم وجامعاتهم؛ أو تحولت إلى ثكن عسكرية، حيث خرجت عن العمل 2600 مدرسة، استخدمت منها 400 مدرسة لإيواء النازحين، و1300 وقعت تحت القصف والتدمير، فيما استخدم ما تبقى كمراكز لإدارة الحرب وأمكنة لإيواء الأسرى والمساجين وخزن القطع الحربية وكل ما يتعلق بالمؤن؛ كل ذلك وأكثر حدث خلال سنوات الحرب الـ6، ونظراً لصعوبة الحصول على المعلومات المؤكدة بسبب احتكارها من جميع الأطراف وعدم تجديد قاعدة البيانات، وتخلف الإدارات المعنية وقِلّة وعيها؛ فإن الأرقام تزيد عن ذلك، لأن أثر الخراب يزداد يوماً عن يوم، وفي تصاعد مستمر مع وتيرة الحرب التي يزداد سعارها وتتشعب جبهاتها وأطرافها وداعموها الإقليميون.
تشير تقارير غير دقيقة إلى أن 2419 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، ذهبوا إلى قوام الجبهات، وهو عدد زهيد أمام ازدياد جثث القتلى منهم، وانتشار صورهم في الشاشات التلفزيونية والمدن والقرى والجبهات.
يكفي أن نقول إن زيارة واحدة للمقابر المستحدثة في طول اليمن وعرضها، ستفي بالغرض؛ ما يعني أن الإحصاءات غير دقيقة في هذا الشأن؛ إذ يرجح أنهم يقدرون بعشرات الآلاف، لأنهم على كل حال الشريحة التي يسهل غسل أدمغتها، والأكثر حماساً لتسجيل البطولة والفداء.
ويكفي أن نقول إن زيارة واحدة للمقابر المستحدثة في طول اليمن وعرضها، ستفي بالغرض؛ ما يعني أن الإحصاءات غير دقيقة في هذا الشأن؛ إذ يرجح أنهم يقدرون بعشرات الآلاف، لأنهم على كل حال الشريحة التي يسهل غسل أدمغتها، والأكثر حماساً لتسجيل البطولة والفداء. وتشير بعض التقارير إلى أن عدد التلاميذ الذين قتلوا في الحرب، يربو على 12 ألف طفل، وهو جيش جرار؛ فلو أن مثل هذا العدد مثلاً يعمل في قطاع الثقافة والفنون، لرأينا وجهاً مشرقاً لبلادنا، أمّا الأنكى والأمر من ذلك كله، فيتجلى في إهمال العملية التعليمية برمتها، وذلك عبر تغييب رواتب المعلمين، ثم إفراغ المدارس من رسالتها، وتحويلها إلى تجمعات للتبرع بالمال المُمول للحرب، وإبدال مدرسين أكفاء بمدرسين جدد لا يعرفون من أمور التربية شيئاً.
أن تعمل بعض القوى -التي تظن أنها منتصرة- على تغيير محتويات المناهج، وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع توجهاتها وميولها العقائدية والأيديولوجية؛ فهذا لعمري المأساة بعينها، وقد كان الحلم أن تتطور مناهج التعليم عبر ربطها بالتحولات العلمية والاجتماعية والأدبية؛ فالعالم يعلي من شأن التعليم بدرجة أساسية.
القصور في مناهجنا
حين اعتصم القضاة في ألمانيا؛ نصبوا الخيام الاحتجاجية، ورفعوا الشعارات الصاخبة، مطالبين الحكومة برفع رواتبهم الشهرية، ومن ضمن الحيثيات التي طرحها القضاة: المعلمون وما يتقاضونه من أجور مرتفعة.. قالوا بأنهم لا يريدون شيئاً سوى مساواتهم بهؤلاء المعلمين. وعندما سمعت رئيسة الوزراء بذلك، وجدتها سانحة حقيقية لتعلي من شأن التعليم؛ فقالت لهم: كيف تريدونني أن أساويكم بمن علموكم..؟ وهي تعني ما تقول، فحزبها الذي فاز بالانتخابات؛ فاز لأن برنامجه يضع الأولوية القصوى للرقي بمناهج التعليم، والاهتمام بالنشء. أقصد أن الكثير من دول العالم تيقظت إلى أن هذا هو مربط الفرس، فمن هنا تتحدد ملامح المستقبل، ومن هنا تتشكل الحياة برمتها. الحديث عن المناهج الدراسية والأدب هو حديث الحياة والصراحة والمكاشفة والصدق؛ إنه التعبير العميق عن الهوية، حيث تعد اللغة وتفرعاتها الأدبية والنثرية، المسلك الوحيد في بناء الشخصية القويمة القادرة على استشراف المستقبل والدفع بالحياة إلى الأمام، وحري بنا ونحن نتحدث عن المناهج المدرسية وعلاقتها بالأدب الحديث والمعاصر والمعاش، أن نتساءل: كيف يمكننا أن نخلق انسجاماً حقيقياً بين التغير الحضاري والتطور الفني؟ ولا شك أن مثل ذلك يحتاج إلى جهود مضاعفة لتحقيق الرؤية؛ فمثلاً في فترة من الفترات تطورت مصر علمياً وعملياً، وتطور فيها الأدب واللغة، وفي منطقة سوريا كذلك، وهو الأمر الذي عده الباحثون اشتغالاً على العملية التعليمية، وهنا علينا أن نتدخل بسؤال جديد: كيف يمكننا إحداث نهضة شاملة؟
إن المتابعة المستمرة لعملية تطور الأدب وما يتعلق به، تمثل الاكتشاف المتواتر لعملية السير والانتقال، كوننا نستطيع عبر ذلك: التمييز بين ما هو عمل فني ورافعة للإحالة، وبين ما هو عمل اعتيادي.. المهم هو ألّا يتحول الفن إلى وسيلة، وإنما إلى غاية بحد ذاتها. ليس عادياً الحديث عن المناهج المدرسية وما يرتبط بها من ملابسات، لأن ذلك يتعلق بمستقبل الأمة.
وكما أن اللغة العلمية لغة دلالية ترشدنا إلى المدلول، فإن اللغة الأدبية هي المادة الخام للحياة الإبداعية، وبالتالي فإننا وحدنا من يستطيع تشكيل مستقبل أجيالنا، ونحن وحدنا المسؤولون عما يحدث من حروب ودمار، لأن القصور في مناهجنا هو الذي أودى بنا إلى هذه الكوارث التي لا تحمد عقباها، لننظر إلى هذه الواقعة التي أوردها الدكتور محمد حسين هيكل، في كتاب “ثورة الأدب”، يقول بأنه حضر مرة مجلساً ضم العديد من الأدباء الكبار، وفيما هم يتناولون أطراف الحديث، سأل أحدهم شيخاً من الشيوخ الضالعين في اللغة: أي الشعرين تفضل؛ الشعر القديم الذي يندرج تحت عنوان “قفا نبك”؛ أم الشعر الحديث الذي عنوانه “حفّ كأسها الحبيب”؟ وقد أجاب الشيخ العارف بأنه يفضل الشعر الحديث، لأنه أكثر عذوبة من سالفه. نستشف من ذلك أن إبقاء مناهجنا على ما هي عليه، يقودنا إلى القول بأننا دعاة قطيعة مع كل ما هو حديث؛ لأن الأدب هو في الحقيقة يمثل الصورة المُثلى للواقع، ولما ينبغي أن يكون عليه الواقع؛ فمن غير الطبيعي أن نحيا عصراً، ونستحضر تفاصيل عصر موغل في القدم، وأنه قد آن الأوان أن نعيش عصرنا بكل تناقضاته.. آن الأوان لأن نعيش واقعنا، ونواجه مشكلاته وننتقد أمراضه، ووساوسه في مناهجنا وأدبيات مدارسنا ومعاهدنا العلمية وغيرها، لأن الأدب هو الحياة.. الحياة بصورتها المدهشة.
هكذا كنا نحلم
إن ما يثير الحيرة والتساؤل حقاً، أن بلداناً كانت تشبه واقعنا العربي، وتتساوى معنا، مثل الهند وباكستان واليابان، إلا أنها اليوم تجاوزتنا، وأصبحت تعد خططاً لزيادة علمائها في مجالات البحث العلمي وأبحاث الفضاء وتخصيب اليورانيوم سلمياً، وذلك في تسابق محموم مع بلدان قطعت شوطاً بالتزامن، مثل الصين وكوريا الجنوبية. ما لا نستطيع فهمه إلى اليوم، لماذا يتطاير العالم من حولنا إلى الأعلى، فيما نحن مانزال أسفل القائمة؟ كيف ننظر إلى بلد مثل الهند مازال أكثر من نصف عدد سكانه يقعون تحت خط الفقر، وكذلك باكستان؟ إن الإجابة على مثل ذلك تكاد تكون في متناول اليد؛ فالوزارات المعنية هي التي تضطلع بالأهداف المرجوة؛ حيث تعمل هذه الدول على إنشاء وزارات ليس من قبيل التجهيز الرخو، والفضفاض، وإنما من قبيل “الحاجة أم الاختراع”.. تعمل هذه الوزارات -التي غالباً ما تكون وزارات التربية أو العلوم والتكنلوجيا- تعمل بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبشكل دقيق ومزمّن، من أجل الوصول إلى الأهداف سريعاً، وهي في الحقيقة تعتمد سلفاً على قواعد مناهج التعليم المدرسي، التي تشكل البنية التحتية للعقل الجمعي.
تعمل هذه دول على إنشاء وزارات ليس من قبيل التجهيز الرخو، والفضفاض، وإنما من قبيل “الحاجة أم الاختراع”.. تعمل هذه الوزارات -التي غالباً ما تكون وزارات التربية أو العلوم والتكنلوجيا- تعمل بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبشكل دقيق ومزمّن، من أجل الوصول إلى الأهداف سريعاً.
ومن دون شك، فإن هذه البلدان حسمت مبكراً قضية المناهج التعليمية، وقاست سلفاً المخرجات، ودور ذلك في تشكيل الهوية الوطنية؛ فكل ما يكتبه أدباؤهم ومفكروهم يعد زاداً لطلاب المدارس. أما مدارسنا، للأسف، فإنها تستقبل كل يوم مندوبي أمراء الحرب الذين يمارسون الغواية بواسطة أحاديثهم الدينية، وذلك استعجال التلاميذ الأبرياء على الالتحاق بكتائب الموت.
نقرأ كثيراً في الصحف والمجلات التي تصلنا، حول العديد من بلدان العالم التي قطعت أشواطاً في مجال ما، ولكننا لا نحاول الاستفادة من بعض التجارب التي قد تلائم واقعنا، ومن التجارب مثلاً: إن الأدباء والرسامين والموسيقيين في إحدى مدن أمريكا اللاتينية؛ قرر المسؤولون على الهيئات التربوية إشراكهم في صياغة مناهج التعليم، ومن ذلك أيضاً الكثير من الاستدراكات، حيث نقرأ أن الأديب فلان الفلاني، قام بإشراك مجموعة من الطلاب في مراجعة وتنقيح روايته التي مازالت مسودة، ويعدها للنشر، ثم نقرأ في مكان آخر أن مجموعة من الشعراء الكبار طافوا بأشعارهم مدارس بلد من البلدان، للتعريف بطرق جديدة للكتابة.
في العالم تحدث مغايرات مشوقة جداً للمتلقين، ومن ذلك أن أعمال أحد الأدباء وضعت على طاولة الطلاب في مختبر إحدى مدارس التعليم الأساسي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
إن ما نوده حقاً أن تكون المدارس والعملية التعليمية والمنهجية على صلة وثيقة بما ينتجه الكتاب والمبدعون. نريد أن تدخل أشعار نزار قباني في مناهج التعليم الأساسي، وكذلك قصائد محمد الماغوط وعبدالكريم الرازحي وعبدالحكيم الفقيه وهيثم، وأدب غادة السمان ونبيلة الزبير وأحلام مستغانمي وأحمد زين ونجيب محفوظ وعلي المقري وحنا مينة والغربي عمران وغيرهم.
كما نريد أن يتناهى إلى أسماعنا أن الشعراء والأدباء يلقون حصصاً أسبوعية في مدارس التعليم الأساسي والثانوي في مدرسة عبدالناصر وثانوية تعز والشعب وبلقيس وأسماء، وأن الطلاب والطالبات يحتفون بالكتابة عن الشاعر الكبير عبدالودود سيف -مثلاً- وأن الشاعر الكبير أدونيس سوف يقدم شهادة عن تجربته الأدبية في مدرسة جمال جميل ومدرسة الإرشاد في ريف تعز، والتي سيتعرض فيها لطفولته، ثم كيف نظر إلى العالم وهو طفل؟ وكذلك الشاعر عبدالعزيز المقالح وأحمد عبدالمعطي حجازي، وغيرهم في المدن الرئيسية والأقاليم.. علينا باختصار أن ندعو الأدباء والكتاب والمفكرين لعمل رحيل جماعي إلى المدارس، من أجل إشعال نهضة في بلداننا لنخرج من عنق الزجاجة والخمول.. إن مثل هذه الصور المشرقة لو حاولنا الاشتغال عليها وإضفاءها على مناهجنا، لحصلنا على نتائج أفضل، ومازال هناك متسع للحلم.